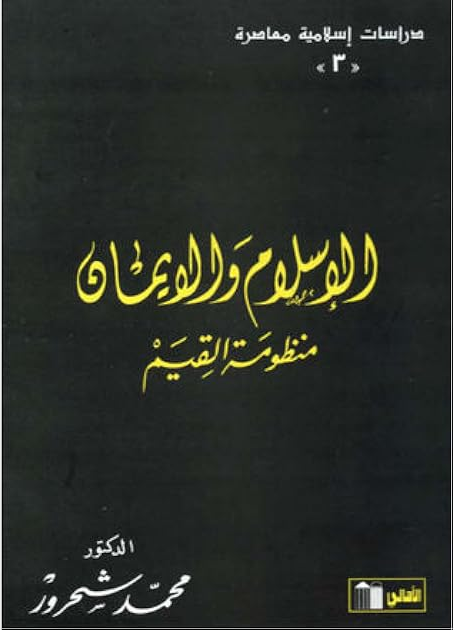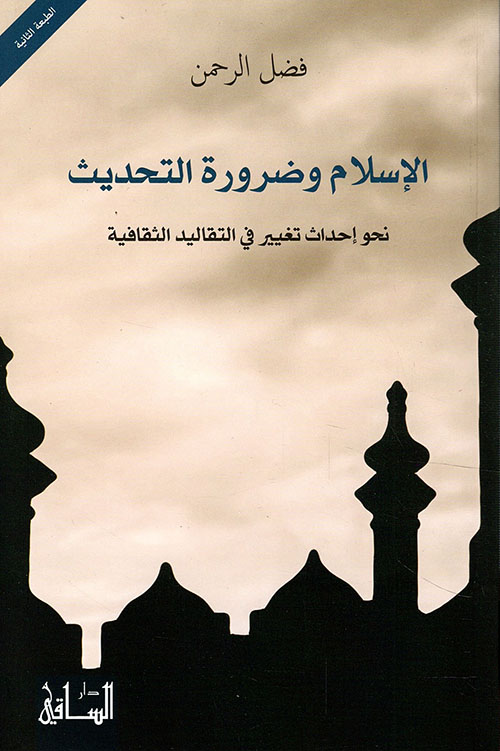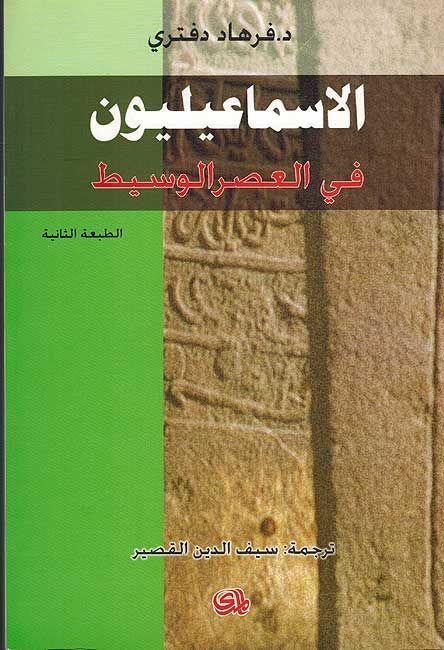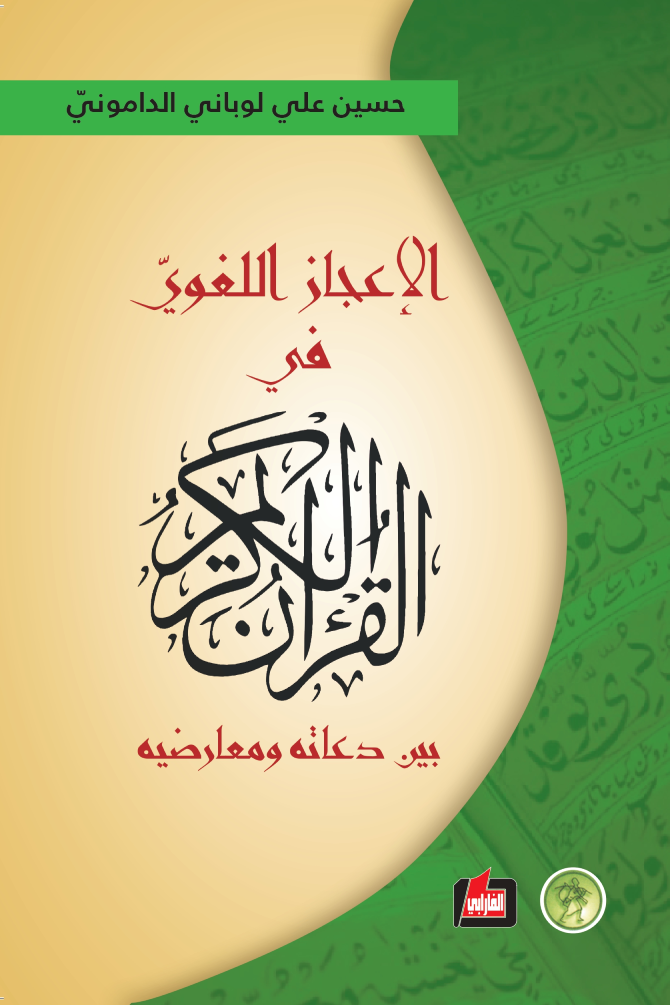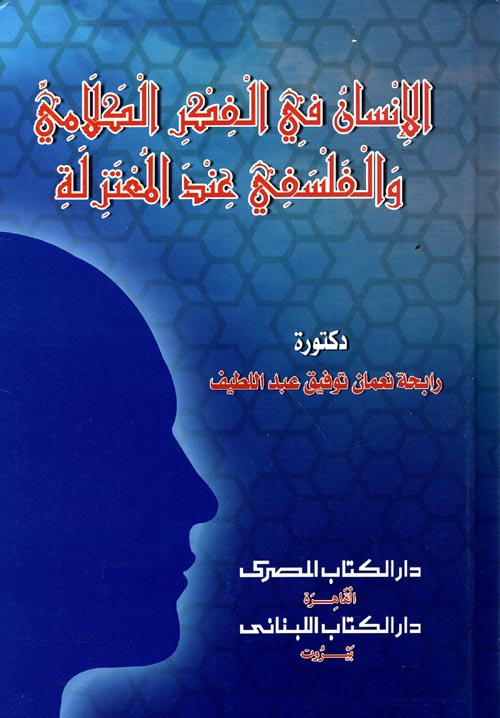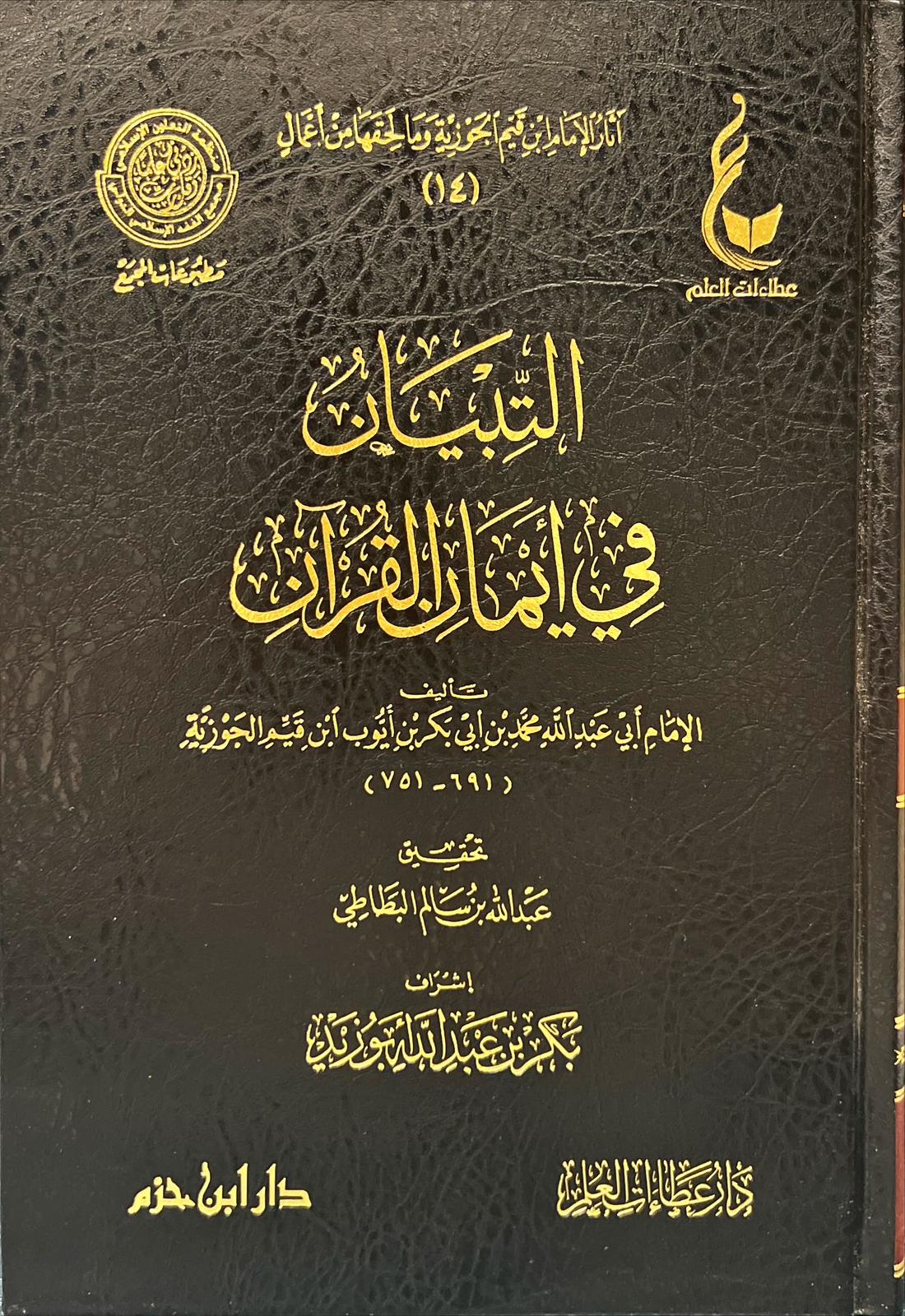عرض السلة تم إضافة “التراث المعماري الاسلامي في مصر” إلى سلة مشترياتك.
عرض 25–36 من أصل 152 نتيجة
الإسلام والإنسان
4.000 دك
بعض الكتابات تعمل على إعادة اكتشاف النصوص التى قادت إلى تصورات مشوهة عن الإسلام، وحملت أفكارا غير صحيحة عنه، منها كتاب "الإسلام والإنسان: من نتائج القراءة المعاصرة"، للكاتب الدكتور محمد شحرو، الصادر عن دار الساقى للنشر والتوزيع، والفائز بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فرع التنمية وبناء الإنسان عام 2017.
والكتاب الواقع فى 208 صفحة من القطع المتوسط، يعد محاولة شاملة للتوفيق بين دين الإسلام مع الفلسفة الحديثة، فضلا عن النظرة العقلانية فى العلوم الطبيعية، حيث يرى الكاتب أن الفوضى الفكرية العارمة فى قراءة الإسلام وتطبيقه، تستدعى وضع التراث جانباً والبدء من النص المؤسس للدين وهو كتاب الله.
يتناول هذا الكتاب الأسس الثابتة للإسلام، الإيمان، المواطنة، والولاء الدينى، معتمداً قاعدة الترتيل منهجية له. والترتيل فى رأى الدكتور شحرور هو نظم الموضوعات الواحدة الواردة في آيات مختلفة فى نسق واحد، وكذلك مبدأ رفض الترادف في فهم نصوص كتاب الله، وتفسير نصوص الكتاب بعضها ببعض.
والكاتب تناول الأسس الثابتة للإسلام كالإيمان والمواطنة والولاء، واعتمد فى كتابه، الذى يعد تطويرًا لمشروعه الفكرى قاعدة الترتيل منهجية له، والمقصود بالترتيل هنا، هو نظم الموضوعات الواحدة الواردة فى آيات مختلفة فى نسق واحد.
ولهذا فإن كتاب "الإسلام والإنسان – من نتائج القراءة المعاصرة" يمثل لونًا من إعادة اكتشاف النصوص فى ضوء المفاهيم الجديدة، كالحرية والمواطنة والإيمان والإسلام، بعيدًا عن مفهوم الصراع والاختلافات، التى قادت إلى تصورات مشوهة عن الإسلام، وذلك حسبما رأت اللجنة المانحة لجائزة الشيخ زايد.
محمد عبدالرحمن
الإسلام والإيمان : منظومة القيم
5.000 دك
أحدثت مسألة الخلط بين مفهومي الإسلام والإيمان ارتباكات كثيرة في هيكلة المنظومة التراثية، فجعلت من الإسلام ديناً عنصرياً همّه الوحيد التفريق بين الناس: هذا مؤمن وهذا كافر، بدلاً من أن يكون ديناً عالمياً قادراً على احتواء الإنسانية والأخذ بيدها نحو التقدّم والرقي.
يحرص الكاتب على بيان الفرق بين الاثنين، وتفكيك عقدة شديدة من عقد المنظومة التراثية، ما يسمح بالتقرّب من رؤيةٍ للإسلام أكثر عقلانية وإنسانية، تمنح له بصفته ديناً المفهوم الذي يستحقّه، وتبعده عن المفهوم المسيّس له، وتُرجع إليه مصداقيته التي أفقده إياها الفهم التراثي له.
ويرى الكاتب أنّ الأساس في أي وعي جمعي، وأي مجتمع يريد بناء دولة، هو الحرية التي هي كلمة الله العليا، وأن الله خلق الناس عباداً لا عبيداً، وأن العبادية هي الحرية، والعبودية هي الاستعباد. وعندما تتحقّق وتتجلّى فكرة عبادية الإنسان لله بأنها عين الحرية، تظهر أهمية الإسلام. كما يرى أن هذه هي الصورة الحقيقية والطبيعية للإسلام، لأنه دين يتماشى مع الفطرة الإنسانية وليس ضدّها، ولأنه جاء يسراً للإنسانية وليس عسراً عليها كما يعرّفه الفقهاء وحماة الرؤية المؤدلجة للدين.
د. محمد شحرور (1938-2019) باحث ومفكّر سوري. حائز دكتوراه في الهندسة المدنية. بدأ دراسة القرآن عام 1970، وهو مرجع أساسي في العلوم القرآنية بعدما أوجد نهجاً جديداً وعلمياً لفهمها.
صدر له عن دار الساقي: «القصص القرآني» (جزءان)، «السنّة الرسولية والسنّة النبوية»، «الدين والسلطة»، «الكتاب والقرآن»، «أمّ الكتاب وتفصيلها»، «فقه المرأة»
عدد الصفحات : ٤٠٢
الإسلام وضرورة التحديث : نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية
4.250 دك
يرى المؤلف أن التطور الثقافي، وبالتالي الاجتماعي، للإسلام قد انطبع وتشوّه بفعل خطأين مترابطين، أولهما ارتكبه أولئك الذين فشلوا في الاعتراف بالفارق بين المبادئ العامة والأجوبة المحددة عن الأوضاع التاريخية والعملية الخاصة.
والحال أن هذا الجمود هو الذي أدّى إلى الخطأ الكبير الثاني، الخطأ الذي ارتكبه العلمانيون. فالدوغمائيون، خلقوا وضعيّة وجدت فيها المجتمعات الإسلامية نفسها مجبرةً على سلوك أحد خيارين: إما أن تتخلى عن الإسلام القرآني، أو أن تدير ظهرها للعالم الحديث.
ففي مواجهة الأصوات التي تنادي بالعودة إلى الإسلام أو بإعادة الشريعة، يطرح الكاتب سؤالاً هادئاً وجريئاً: أي إسلام، وما هو الإسلام؟ ثم وبشكل أهم: كيف يمكن الوصول إلى إسلام «نمطي»؟
يرى المؤلف أنه إذا كان الإسلام يريد أن يكون ما يزعم المسلمون أنه كائنٌ عليه، فإنّ على الباحثين المسلمين أن يعيدوا تقييم منهجياتهم وتأويلاتهم.
فضل الرحمن (1919-1988) مفكر إسلامي باكستاني، ترك بعد وفاته تراثاً لا يزال متداولاً بالبحث والتحليل في أغلب الجامعات الغربية والمنتديات الثقافية العالمية.
عدد الصفحات : ٢٤٨
التأويل بين فخر الدين الرازي وابن تيمية
4.000 دك
هل يشتمل القرآن على محكم ومتشابه أن أنه كله محكم؟ هل هناك مجاز في القرآن الكريم خاصة فيما يتعلق بالصفات الخبرية أن الألفاظ على ظاهرها؟ ما هو النهج الصحيح لفهم النصوص الدينية هل التأويل أو التفويض؟ هل التأويل ضرورة عقلية تفرضها طبيعة البحث في العقائد الإسلامية؟ هل إيمان المسلم بظاهر النص دون تأويل يعد إيماناً صحيحاً؟
إن محاولة الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها حول موضوع التأويل فضلاً عن أهميته وارتباطه بمسألة الصفات الإلهية ومع لها من انعكاسات خطيرة حول فهم المسلمين للنصوص هي التي دفعت "رمضان علي حسن القرنشاوي" لتناول ودراسة هذا الموضوع وهو دراسة تأويل الصفات الخبرية عند الإمام الرازي والإمام ابن تيمية وذلك لما حظت به الصفات الخبرية من تأويلات متعددة بالإضافة إلى أن أكثر التأويلات الواردة في مسالة الصفات تتعلق بها.
ويرجع اختيار المؤلف لدراسة التأويل عند هذين العالمين، أن الأول يمثل الاتجاه الأشعري، والثاني يمثل الاتجاه السلفي أما منهجه في إعداد الدراسة فهو المنهج التأريخي التحليلي المقارن، هذا وقد اقتضت منه خطت الدراسة أن يتألف بحثه من مقدمة ومدخل وبابين: أما المقدمة فقد قام فيها المؤلف بالتعريف بمبحثه وتوضيح أهميته والإشارة إلى المنهج المستخدم في إعداده كما أشار إلى التساؤلات الموجهة للدراسة.
أما المدخل وعنوانه "مفهوم التأويل وتطوره لدى مفكري الإسلام السابقين على كل من الإمام الرازي وابن تيمية" وفيه عرض المؤلف لمفهوم التأويل من حيث الاشتقاق اللغوي والاصطلاحي عرض لمفهوم التأويل في استعمال القرآني مسترشداً بآيات من القرآن وبيان معناها عند أهل التفسير كذلك عرض المؤلف لمفهوم التأويل عند الصحابة والتابعين مبيناً الفرق بين التفسير والتأويل.
أما الباب الأول وعنوانه "مفهوم التأويل عند الإمام الفخر الرازي" فضمنه عرض لموقف الإمام الرازي عن التأويل لدى السابقين عليه، من ثم تحدث عن تأويل صفات الذات الخيرية عند الإمام الرازي، كما وتحدث عن صفات الفعل الخيرية عند الرازي، وأما الباب الثاني فخصصه لبيان موقف الإمام ابن تيمية عن السابقين عليه ونقده لمفهوم التأويل عند الإمام فخر الرازي.