عرض السلة تم إضافة “سجل دائم” إلى سلة مشترياتك.
سيكولوجية المال
6.000 دك
هدف كتاب سيكولوجية المال هو إيصال فكرة بأن التعامل مع المال ليس له علاقة بمستوى الذكاء،
ولكن علاقته أكثر بسلوكك وتصرفاتك، وهذه أمور صعبة حتى على الأذكياء.
مثال، اذا كان هناك شخص عبقري في الأمور المالية، ولكن يفقد السيطرة على تصرفاته، سوف يحقق كارثة مالية.
بينما شخص عادي جدا ولكن يعرف كيف يتصرف في الأمور المالية من الممكن أن يكون ثروة كبيرة.
 اسم المؤلف : مورجان هاوسل
اسم المؤلف : مورجان هاوسل
 اسم المترجم : كنان القرحالي
اسم المترجم : كنان القرحالي
 دار النشر : دار كلمات
دار النشر : دار كلمات
متوفر في المخزون
التصنيف: سياسة وإقتصاد
معلومات إضافية
|
|
مورجان هاوسل |
|---|---|
 دار النشر
دار النشر
|
دار كلمات |
 اسم المترجم
اسم المترجم
|
كنان القرحالي |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “سيكولوجية المال” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
آخر الشهود
4.500 دك
كُتب الكثير عن بطولات ومآثر الحروب، وعن مدى الحاجة إليها بوصفها وسيلةً لتحقيق أهداف قد تُعدُّ نبيلة. لكن بقي السؤال الدائم: هل يوجد تبرير للسلام ولسعادتنا وحتى للانسجام الأبدي، إذا ما ذُرفت دمعةٌ صغيرةٌ واحدة لطفلٍ بريءٍ في سبيل ذلك؟ في الحرب العالمية الثانية، قُتل وجُرح وهُجِّر أكثر من مئة مليون شخص في حرب هي الأكثر دموية –حتى الآن – في تاريخنا البشري.
وقد كُتب الكثير عن مآسي ونتائج هذه المرحلة القاتمة من تاريخنا. ولكن كيف رآها آخر الشهود الأحياء؛ أطفال هذه الحرب؟ بعد أكثر من ثلاثين عاماً على نهاية تلك الحرب تُعيد سفيتلانا في كتابها مَن بقي من أبطال تلك المرحلة إلى طفولتهم التي عايشت الحرب، لتروي على لسانهم آخر الكلمات... عن زمان يُختتم بهم... لا تعليقات للكاتبة في أول وآخر الكتاب، كما جرى في كتابيها المترجمين "صلاة تشرنوبل" و"فتيان الزنك"، تاركةً كل المجال الفسيح للذاكرة والورق على الامتلاء تلقائيًا، وللقارئ الكثير من الوقت للتأمل بخرابات الأرض، ولا أجوبة يمكن أن تسوقك إليها الروايات، هي وثائقيات ومذكرات لتحفيز البحث في كوارثنا. لعل ذلك لا يعيدها.
في آخر الشهود ، تترك الكاتبة المجال فسيحًا للذاكرة والورق على الامتلاء تلقائيًا "الكتاب أقرب إلى الرواية المونولوجية، أو الرواية متعددة الأصوات، التي قامت ألكسيفيتش باعتمادها وتوظيفها في مجموعة رواياتها الوثائقية، القائمة على البوح والاستحضار والتذكر، ومجموعة من العمليات الذهنية وضعت فيها شخوصها ضمن ذلك الظرف من السرد" ألترا صوت
عدد الصفحات : 3
البدون في الخليج : إشكالية الدولة والمواطنة
5.000 دك
لم يتشكل مفهوم المواطنة دفعة واحدة، بل تطور تدريجياً كمفهوم ديناميكي عبر عملية تاريخية ونضالية ومطالبات مستمرة. كانت المواطنة في الأزمنة الغابرة تُعتبر مجرد أداة للسيطرة والتمييز. وفي العديد من الحضارات القديمة، كانت الحقوق المدنية والسياسية مقتصرة على فئة ضيقة من الأفراد، في حين كانت الأغلبية العظمى من الناس تعيش في ظروف تشبه العبودية.ويمثل ملف انعدام الجنسية عالميا ، واحداً من اكثر ملفات المعاناة الانسانية، وينسحب ذلك على دول الخليج، التي أصبح "البدون " فيها هم الغائبون الحاضرون، حيث دفعت بهم ظروف اجتماعية، او سياسية، او جغرافية، خارجة عن ارادتهم، ان يفرض عليهم العيش في الهامش، الى الساحة الخلفية للمجتمع، والى أشد الاماكن فيه وعورة، وظلمة، وعزلة، وغربة وضياعا.
وهكذا تحول البدون الى اشكالية تؤرق المجتمعات الخليجية في الداخل، والمنظمات والمؤسسات الدولية في الخارج، بينما تستمر في الوقت ذاته السياسات العاجزة عن ايجاد حلول حاسمة وجذرية لحل محنة "البدون" من منطلقات حقوقية تحفظ كرامة الانسان وتحقق استقرار المجتمع، الامر الذي ادى الى تداعيات سلبية اضرت بسمعة دول الخليج في الساحة الدولية، والاستمرار بحرمان الاف البدون من حقوقهم، واعاقتهم عن ممارسة دورهم في الاسهام والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع الذي ينتسبون اليه.
الطاغية
3.000 دك
الديمقراطية والديكتاتورية كلاهما وجهٌ لعملة واحدة هي السلطة، كما أنّ أفلاطون رفض فكرة الديمقراطية منذ بداية ظهورها، وعَدّ الحكم الديمقراطي حكماً فاسداً، بل جعله في مرتبة متردّية بين النظم الفاسدة، ووضعه في المرتبة قبل الأخيرة في سلّم الانحطاط بعد حكم الطغيان، وذلك في كتابه «الجمهورية». وفي المرتبة المتردّية نفسها صنّف أرسطو الديمقراطية في تصنيفه السداسي لأشكال الحكم، الذي عرضه في كتابه «السياسة»، حيث عَدّ الديمقراطية ضمن أشكال الحكم المنحرفة والفاسدة، التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة. واستمر نقد فكرة الديمقراطية ومعارضتها حتى في زمن الإمبراطورية الرومانية. وفي ظلمات العصور الوسطى لم يعد أحدٌ يذكر أو يناقش فكرة الديمقراطية، في وقتٍ أنار فيه الإسلام العالم بمفاهيم حضارية قائمة على العدل وإنسانية الهدف والوسيلة.
وبعد ألفي عام تقريباً، جاء الشاب آليفيري ليعرّي مفهوم الاستبداد/الطاغية أينما وجد، سواء تقنّع بالملكية، أم بالجمهورية، وكأن آليفيري يعيش بيننا اليوم ويدرك جميع ألاعيب الحكم وما يحيطه من خطط ومن شخصيات وصولية، وكيف تتشابه أوجه السلطة وإن اختلفت ألوانها. يحلّل آليفيري مفهوم الاستبداد/الطاغية تحليلاً مجهرياً كما يفعل عالم البيولوجيا عندما يدرس الميكروبات المفيدة والضارة من أجل الوصول إلى نتيجة لا تتبدل ولم تتبدل عبر التاريخ، ألا وهي السلطة التي تجدّد نفسها على حساب الجميع، بمن فيهم الملوك والرؤساء، وتحرق كل من يعيق ديمومتها، وهذا بات اليوم واضحاً لجميع شعوب الأرض، ولم يبقَ أمامهم إلا أن يتوحدوا تحت مظلة الإنسانية والعودة إلى التشريعات الإلهية، كي ينقذوا سلامتهم من براثن الاستبداد، وهذا لن يحدث إن لم ينتصروا على نرجسية طموحاتهم التي منها يقتات الطغيان وجوده.
عدد الصفحات: ١٦٠
تهويد المعرفة
2.500 دك
نحن لم نخسر الأرض والوطن والبيوت والمزارع فقط، بل خسرنا التاريخ ومنابع المعرفة أيضاً. وهذا يكشف لنا عن الاتساع الحقيقي لميدان الصراع، أن الصراع قائم وفي غيابنا، في كثير من الأحيان في العالم كله، في الجامعات والدراسات والتعليم والموسوعات والتكوين وعقل هذا العالم.
وليس في فلسطين وجوارها والمخيمات فقط، اكتشاف كهذا يجب أن يدفعنا إلى التعويض عن غيابنا عن ميادين كثيرة في هذه المعركة المصيرية.
عدد الصفحات : ١٠٠
زمن مستعمل
6.000 دك
شهدت روسيا عدة ثورات واضطرابات وحروب أهلية دامية في بدايات القرن العشرين، نجم عنها ظهور الاتحاد السوفيتي الذي شكل صورة عن الإمبراطورية العظيمة التي لا تُقهر.
رأى فيها البعض تحقق الحلم الاشتراكي الأحمر في بناء دولة عظمى، امتد نفوذها على نصف العالم تقريباً. بينما رأى فيها البعض أحد أقسى أشكال الحكم الشمولي القمعي بمعتقلات هائلة ووضع اقتصادي صعب.
في العام 1991 انهارت الإمبراطورية السوفيتية بشكل متسارع بعد عدة ثورات واضطرابات وحروب أهلية دامية، واستيقظ الإنسان الأحمر ليجد نفسه فجأة يعيش في أنقاض إمبراطورية تتهاوى إلى عشرات الدول المتصارعة، وتشهد انهياراً اقتصادياً هائلاً ونهاية الأحلام الكبيرة التي عاشها. فكانت نهاية الانسان الأحمر.
في كتابها، لا تبحث سفيتلانا أليكسييفيتش عن إجابات للأسئلة الكبيرة التي تهم قارئ التاريخ، بل عن آلاف التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية المنصرمة عبر جمع عشرات الشهادات لبشر عاديين عاشوا هذه التجربة وتقلباتها. تبحث سفيتلانا عن الأحاديث الليلية الصغيرة التي تختفي مع الصباح، عن الحلم بمستقبل جديد، بزمن آخر. إلا أنه الزمن نفسه مكرراً؛ زمن مستعمل.
عدد الصفحات :٦٠٨
سنوات صدام
4.000 دك
لأكثر من خمسة عشر عامًا، كان سامان عبد المجيد المترجم الشخصيّ للرئيس صدّام حسين عن الانجليزيّة والفرنسيّة، والمسؤول عن المكتب الصحافي للرئاسة، وخدم أيضًا عديّ، الابن البكر للرئيس صدّام،
وقد أتاحت له وظائفه هذه حضور نحو مئةٍ من اللقاءات في القصر الرئاسيّ أو بيت الرئيس بتكريت.
لقد كان، إذن، شاهدًا مباشرًا على محادثاتٍ رسميّة وغير رسميّة مع سياسييّن مثل جان بيير شوفنمان، جان ماري لوبين، يفغيني بريماكوف، ومع صحافييّن مثل كريستين أوكرنت، بوافر دارفور، ودان راثر، ومع دبلوماسييّن قدموا من باريس، والفاتيكان، والكريملين، والبيت الأبيض.
وقد ظلّ سامان عبد المجيد في خدمة الرئيس صدّام حتّى سقوط بغداد، فهو أقلّ عضو في النظام يشهد على انهيار السلطة، وعلى ارتباك الموالين لها بعد أن ضلّت بهم السبل، وأوصدت في وجوههم كلّ الأبواب، فرواية سامان عبد المجيد الغنيّة بالأسرار، عن كواليس الدكتاتوريّة العراقيّة، تتيح للقارئ الإلمام أكثر بشخصيّة الرئيس صدّام حسين.
وعدا عن ذلك، فإنّه يقدّم لنا إجابات عديدة على نقاطٍ كثيرةٍ ظلّت غامضة: وجود شبيهٍ واحد أو أشباهٍ عديدين للرئيس صدّام، والعلاقات الشخصيّة لبعض الغربييّن مع بغداد، وتمويل العراق للعديد من زعماء العالم الثالث، والوساطة السريّة لأحد مبعوثي بيل كلينتون، ثم الحوار المغلق مع كوفي عنان، والقطيعة مع فرنسا.
إنّ الكتاب « سنوات صدام » هو وثيقة فريدة من نوعها عن سنوات المناورات والأزمات
قتلة زهرة القمر: جرائم قتل الأوساج وولادة مكتب التحقيقات الفدرالي
6.000 دك
الهنودُ الحُمر الأميريكيّون الأوساج استُهدِفوا بجرائم قَتلٍ كثيرة ، متسلسلة ومنهجيّة ، من أجل الإستيلاء على ثرواتهم الطائلة ، والجرائمُ التي استُهدِفوا بها ، ما هي إلاّ جَرائِمُ إبادةٍ عِرقِيّة تُعَدُّ – وعلى ما يؤكّد الكتاب الذي نحن بصدده هنا – بأنّها من أكبر الجرائم ضدّ الإنسانيّة . ولقد شكّلت هذه الجرائم سبباً إجباريّاً لولادة مكتب التحقيقات الفِدراليّ في الولايات المتّحدة ، وهو المكتب الذي أُنشِءَ خصّيصاً من أجل التحقيق في هذه الجرائم .
وهذان الأمران ( جرائم القتل وإنشاء المكتب ) يكشفهما ، وبِالتّناوُل الشامل ، كموضوعٍ موحَّدٍ ، ألكتابُ الصادر، حديثاً في ال2023 ، وفي طبعة عربيّة أولى ، عن ” شركة المطبوعات ” في بيروت ، تحت عنوان : ” قَتَلَةُ زَهرة القمر( جَرائِمُ قَتلِ الأوساج وولادة مكتب التحقيقات الفِدرالي ) .
لعبة الأمم : اللاأخلاقية في سياسة القوة الأمريكية
4.250 دك
تعني عبارة “لعبة الأمم” ذاك النشاط الذي بدأته وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بغية وضع المخططات المناسبة لبسط النفوذ الأميركي على بلاد العالم عن طريق السياسة والخداع بدل اللجوء إلى الحرب المسلحة.
وهكذا يقترب معنى هذه الجملة من “التخطيط السياسي للصراع على مناطق النفوذ في العالم عن طريق الحرب الباردة” ولمزيد من التوضيح يرى سكوت فيتزجرالد في مسرحية له، تجلى فيها الذوق الإجتماعي وقواعد الأتيكيت بأبهى مظاهرهما، أن بعض المصادمات التي وقعت بين كرام القوم، كانت تصل إلى طريق مسدود لإعتقاد الجميع أن مواقفهم هي الحق ولن يحيدوا عن سلوكهم الأخلاقي قيد أنملة.
وفي خضم هذا التزمت الأخلاقي والتشبت بقواعد “الأتيكيت” كان ينبري بعض السوقة لفض النزاع، وإنهاء الخلاف بطريقة لا تشجع السيدة أميلي بوست على إستحسانها في كتابها الشهير “الأتيكيت”.
غير أن أمثال هذه الحالة شائع جداً في الأجواء الدبلوماسية عامة، فكم من أزمة سياسية بين دول عديدة تعقدت وطالت، نتيجة إصرار تلك الدول على مواقفها، خشية مخالفة المبادئ السامية والحصافة الدبلوماسية!!!! وكم من مرة أيضاً انتهت تلك الأزمات الحادة إلى سلام ووئام بفضل وسطاء طارئين، دون أن يفقد زعيم ماء وجهه أو تُهتدْر كرامة شعبه.
ولا تزال تجول في خواطر الكثيرين – ولا شك – أسئلة عديدة عمن وراء زحزحة المصريين والبريطانيين عن مواقفهم المتعنتة أثناء مفاوضات الجلاء عن السويس عام 1954؟ ومن الذي أطاح بحكومة الدكتور مصدق في إيران؟ وكيف ثبت الناصريون أقدامهم في لبنان عام 1985 على مرأى ومسمع مشاة الأسطول الأمريكي السادس، الذين كانوا ينعمون بشمس لبنان وشواطئه الدافئة؟ ولماذا أحجم عبد الناصر عن ضرب إسرائيل في وقت كان مستعداً لذلك ودفع بشعبه لحربها وهو في أقل حالات الإستعداد لها؟.
فالمؤرخون عندما يؤرخون الحوادث، يهملون الجواب على مثل هذه التساؤلات، ويمتنعون عن إلقاء الضوء عليها لأنهم نادراً ما يعلمون عن خفاياها شيئاً، وكذلك يهملها الدبلوماسيون في مذكراتهم مدفوعين بإعتبارات الأمن تارة، وبالرغبة في عدم الإيقاع بين الحكومات وشعوبها تارة أخرى.
وهكذا تبقى الأحداث مدفونة لا تعرف منها خافية، ولا ينكشف للجماهير منها سرّ، إلا ما كان بمحض الصدفة، بينما يقع الذين أشرفوا على وضع تصاميمها، وقاموا بتنفيذها، خلف جدران دواوينهم الرسمية ينتظرون الفرصة السانحة ليزيحوا الستار عنها، ويظهروها عارية على حقيقتها أمام شعوب هذا العالم المخدوع.
ولكن مايلزكوبلاند مؤلف هذا الكتاب، ورغم المسوغات لإخفاء ما يعلم من أسرار لعبة الأمم، لم يجد المؤلف بدّأ من تأليف كتابه هذا الذي زجره صديقه الدبلوماسي وعندما دفع بمسودته إليه لمحاولته كشف النقاب عن الأسرار التي يجب – برأيه – أن تبقى في زوايا النسيان حتى لا تشوه سمعة الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات أمام شعوبها.
وبداية يعطي المؤلف صورة عن أساليب الحكومة الأمريكية في معالجة الأمور الداخلية والأهم منها الخارجية، فهم رجال يبذلون ما في وسعهم لإظهار أنفسهم – في كتاباتهم – بمظهر المتفائل المستبشر، ولكنهم ليسوا كذلك، وعلى سبيل المثال أنه وعندما يقع تضارب بين نتائج كلا الإدارتين الخارجية والداخلية يعمد رئيس الجمهورية إلى ترجيح كفة العلاقات الخارجية على حساب الإتجاهات الداخلية حتى لا تقف حجر عثرة في طريق المضي قدماً للمحافظة على نوع وحجم العلاقات الأمريكية الخارجية…
ونتيجة لذلك فبينما هي ترفض علناً التدخل في شؤون الدول الأخرى، تبحث عن أساليب مبتكرة خارج جهازها التقليدي لتفعل ذلك، ولا يكون على الحكومة عندئذ إلا أن تشرع بتحديد معالم وحدود القضية المعنية، ومن ثم تقوم بإطلاق العنان لعدة قوى خفية تتكفل بتصفيتها كليّاً، أو إزالة أخطارها، دون أن تتورط الحكومة رسمياً في أي جانب من جوانبها.
وتبدأ اللحظة الحرجة عندما يبدأ الصراع المستتر بين هذه القوى ومثيلاتها في الدول الأخرى وكلها تعاني المشكلة نفسها المشتركة بينها ألا وهي: إظهار النزاهة والإستقامة وإضمار الغدر والخداع ونية التلاعب بالأمم والشعوب.
وهنا يختتم المؤلف كلامه عن أساليب الحكومة الأمريكية في إدارة شؤونها الخارجية بالقول: “وهكذا نصل إلى موضوع كتابي هذا وهو ما أسميه “لعبة الأمم” مبيناً أنه ولئن كان معظم هذا الكتاب يدور حول منطقة الشرق الأوسط عامة، والدولة المصرية خاصة، فإن مردّ ذلك إلى بضعة عوامل منها: الفرصة التي أتيحت له في تمضية لا بأس به، وهو يمارس كثيراً من تلك الأدوار المستترة بصفته وسيطاً طارئاً لن يكون بين المدعوين ثانية، وهذا ما يسميه بدبلوماسية ما وراء الكواليس، مشيراً إلى أن لهذا النوع من الدبلوماسية أثر كبير، ظهر في سلوك حكام تلك المنطقة في علاقتهم بالغرب، وعلاقات الغرب معهم، والذي كان يبدو لأول وهلة، أنه سلوك يمجّه الذوق السليم ويرفضه المنطق الصحيح، والذي يبدد في ظاهره خطوط متقاطعة متباعدة لا يتوازى منها اثنان.
وإلى هذا، فإن المؤلف يعتبر كتابه هذا نموذجاً حيّاً للتاريخ يهدف إلى إزاحة الستار عن حقيقة إرتباطات الدول الكبرى بالدول المحدودة الإمكانيات التي نجحت أحياناً في إحراز نصر دبلوماسي على بعض الدول الكبرى، وتمكنت مع الأيام من ممارسة دور أكبر من طاقاتها في السياسة العالمية؛ ومثاله على ذلك دور عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية.
ويعود ليذكر القارئ بألا يتبادر إلى ذهنه أن الأخطاء والهفوات التي طرأت على العلاقات الأمريكية الدولية كانت نتيجة قرارات حمقاء، كاشفاً عن أنها ليست في حقيقتها أكثر من سوء فهم عند كبار المسؤولين لجوهر الأمور، أو سوء إستعمال للوسائل المبتكرة لمعالجة أمور استعصت على الوسائل التقليدية، والذي يبدو واضحاً في معاملة الحكومة الأمريكية للرئيس عبد الناصر.
ويختتم المؤلف ذلك بالقول “وسأبقى – ما استطعت إلى ذلك سبيلاً صادقاً في وصفي للأحداث، بطيئاً عند منعطفات تاريخ الشعوب، مبتعداً عن إختلاق الأخبار مهما كانت واجباتي وإرتباطاتي.
عدد الصفحات : ٣٢٠
دار الأهلية

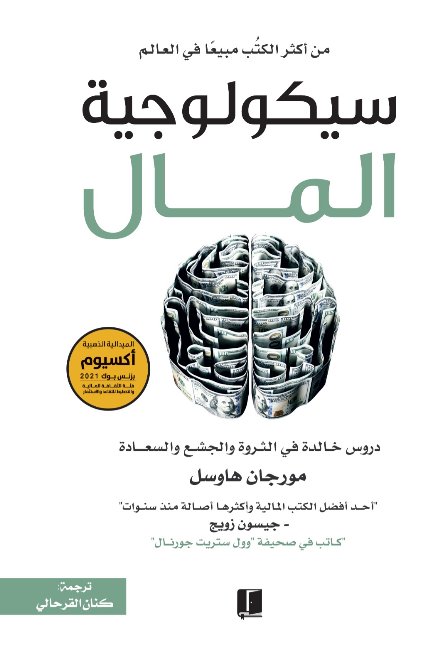
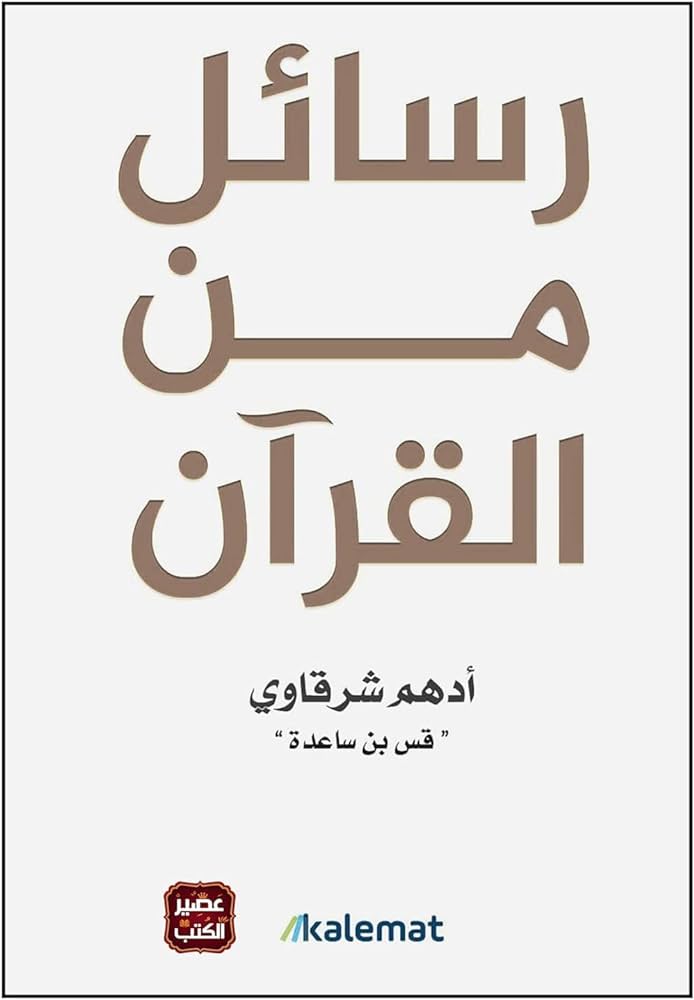
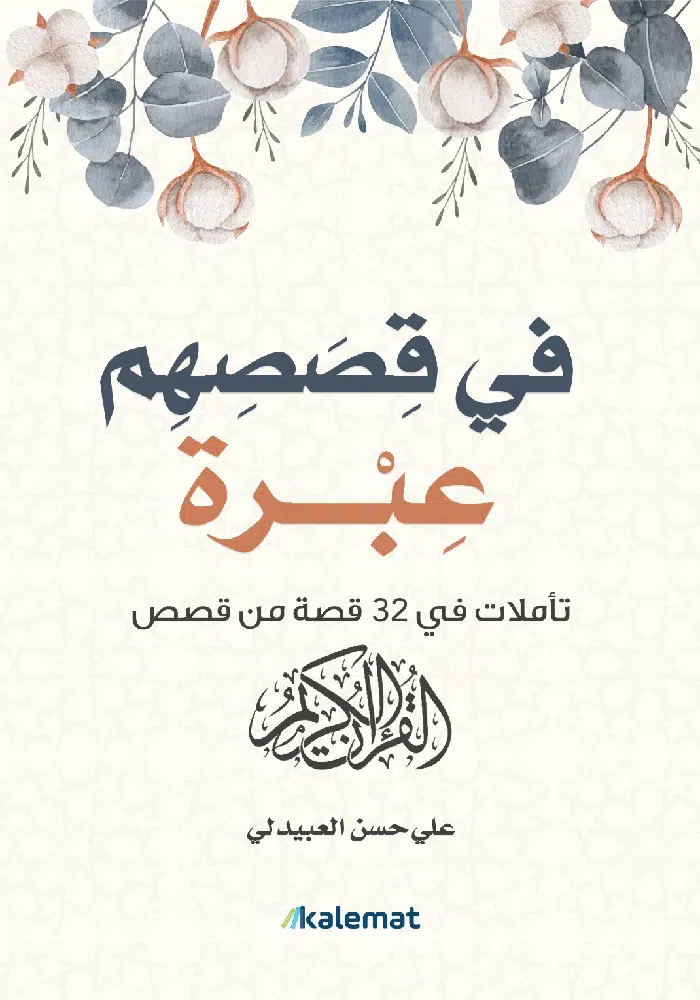




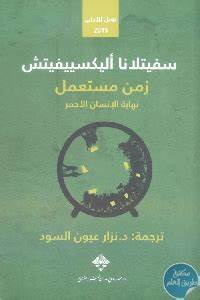




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.