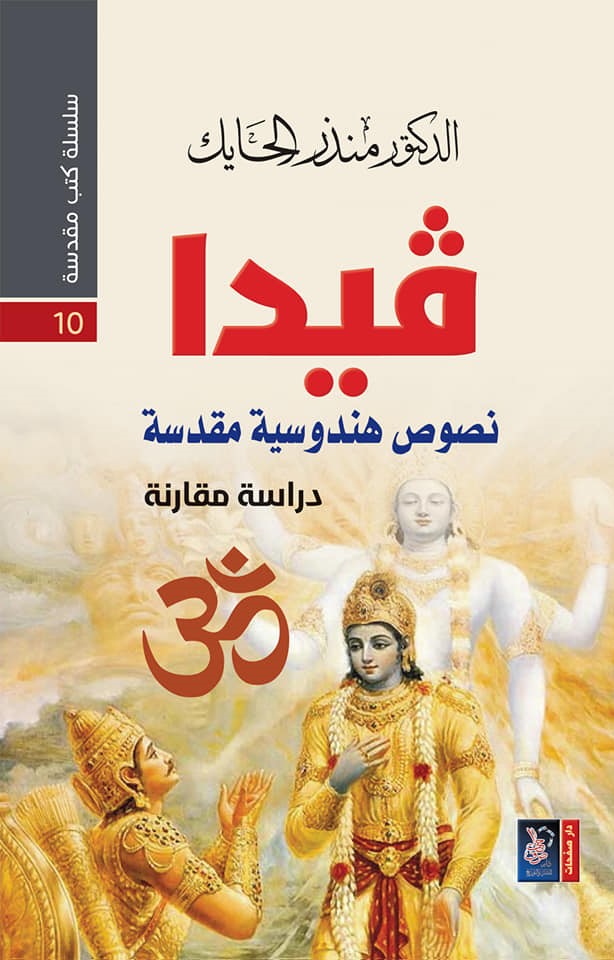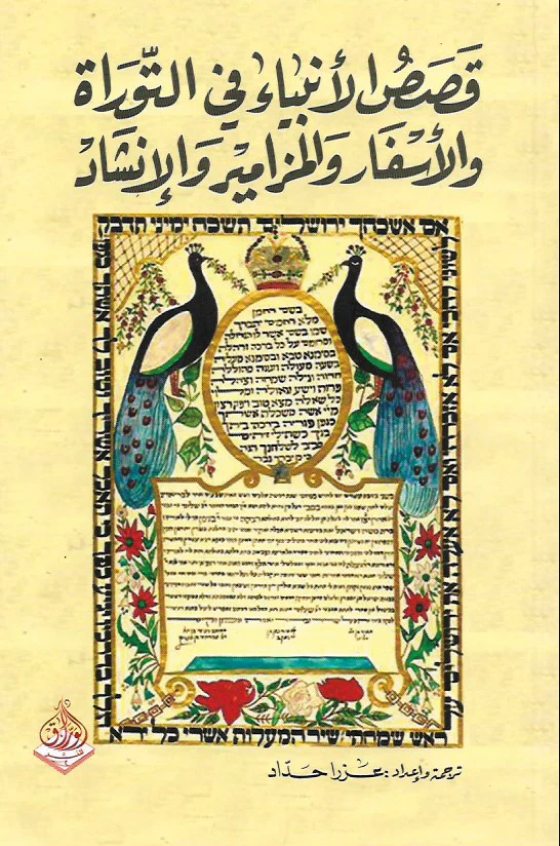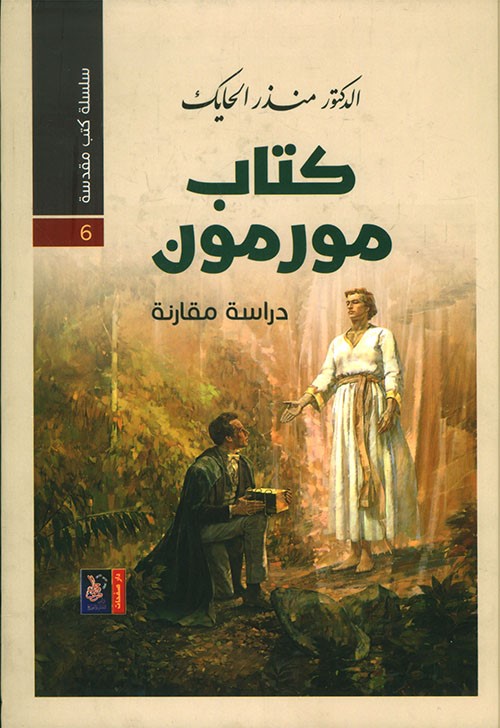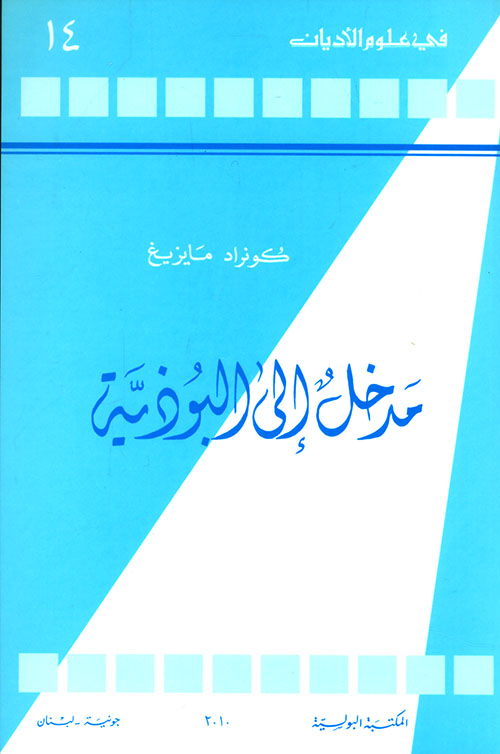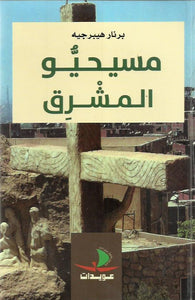عرض 61–72 من أصل 77 نتيجة
عقائد البعث والخلود عند القدماء المصرين
عقائد مابعد الموت عبر العصور
عن تاریخ تطور الصلاة والشعائر الإسلامية
فيدا نصوص هندوسية مقدسة
قصص الأنبياء في التوراة والأسفار والمزامير والإنشاد
كيف راى أينشتاين الإله
"لدى تيبيت براعة في العثور على المفكرين الذين يناقشون الأسئلة العميقة والمهمة." روبرت رايت، مؤلف كتاب The Evolution of God "تُعد كريستا تيبيت نسخة معاصرة من الفيلسوفة سيمون فايل. لقد عكفت على مزج الحياة الروحية والثقافة العلمانية ببراعة مثيرة للإعجاب عبر حواراتها مع الفيزيائين، والشعراء، وعلماء الأعصاب، والروائيين، والبيولوجيين والرهبان البندكتيين، الذين تجمعهم سمة العقل والقلب التي منحها آينشتاين اسمًا جميلًا هو "العبقرية الروحية". لقد أوجدت مساحة نادرة للتفكر والانعتاق وسط ثقافتنا الرجعية؛ لكي تستكشف حياة لها معنى." ماريا بوبوفا، Brain Pickings "كريستا تيبيت هي أستاذة العثور على القوزاق الدقيقة، وفي نظرها تسمو الأسئلة الإيمانية العظيمة فوق الإجابات البسيطة التي تقدمها الأديان." أندرو سولومون، مؤلف كتاب Far From The Tree "لقد ذكّرتنا كريستا تيبيت من دون كلل بالتحدي الدائم، وبالعمق، وبالتعقيد الذي يتسم به المسعى الروحي." كارين أرمسترونج، مؤلفة كتاب The Case For God "تتمكن كريستا تيبيت من امتلاك المساحة الوسطى؛ وهي مساحة كبيرة للغاية وشاملة يعيش أغلبنا فيها معظم الوقت، وهي مكان يجيب علينا أن نعيش فيه ونتفكر في الأسئلة الدائمة المتعلقة بالإيمان، والشك، والمعنى، تلك الأسئلة التي طالما كانت في قلب الخبرة البشرية منذ قديم الأزل." باتريشيا هامبل، مؤلفة كتاب The Florist's Daughter
كيف رأى اينشتاين الإله
كريستا تيبيت
دار التنوير