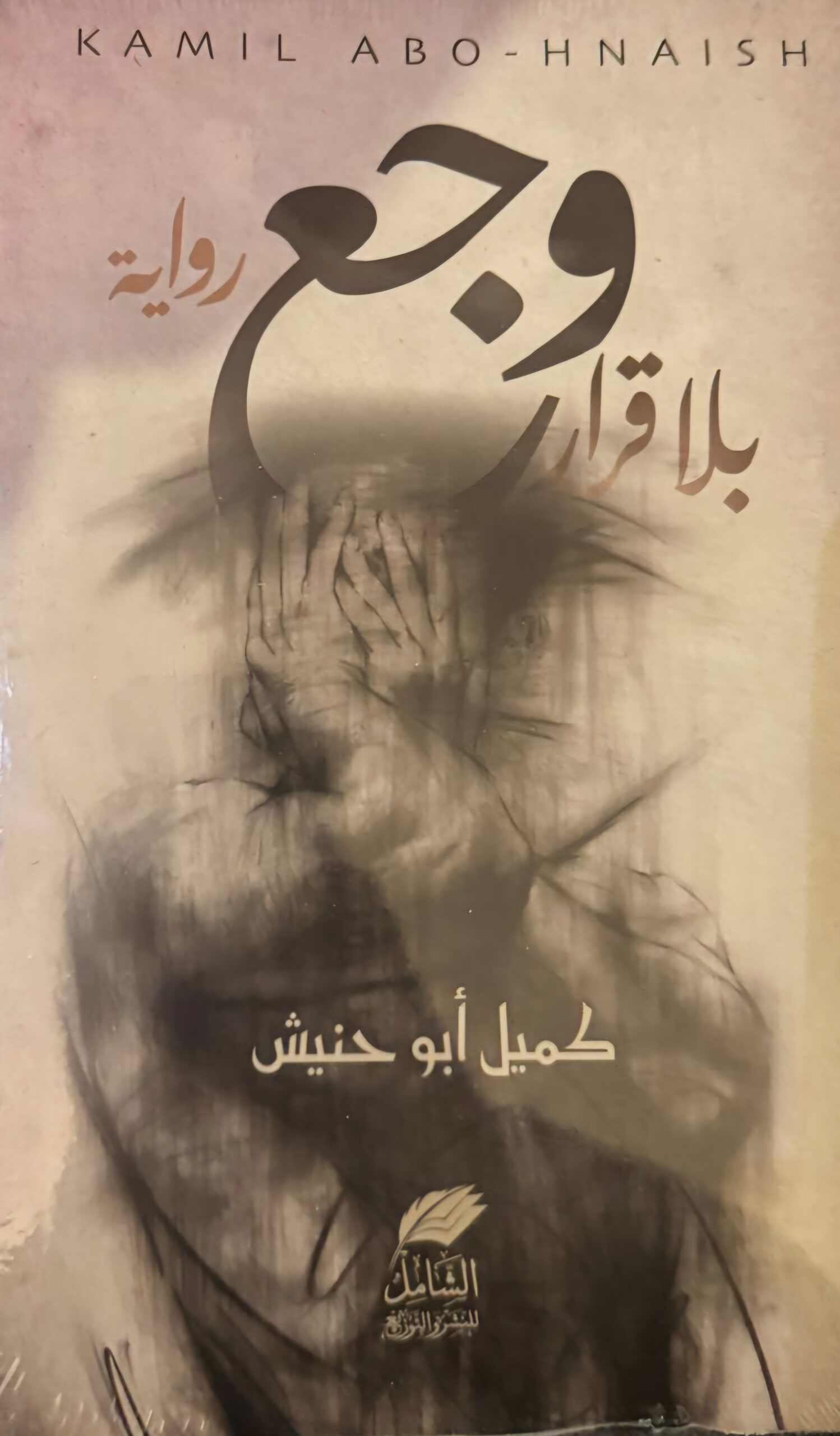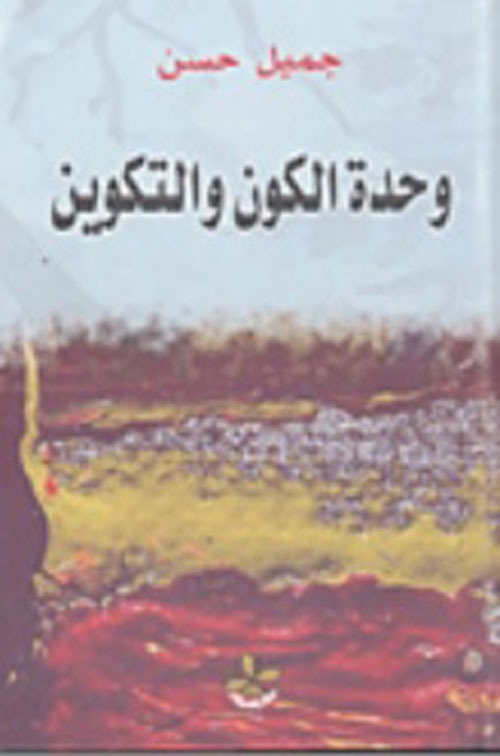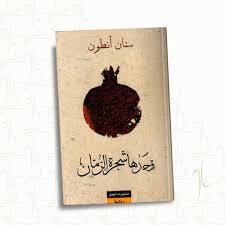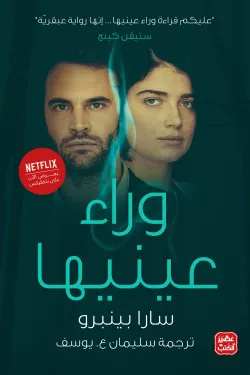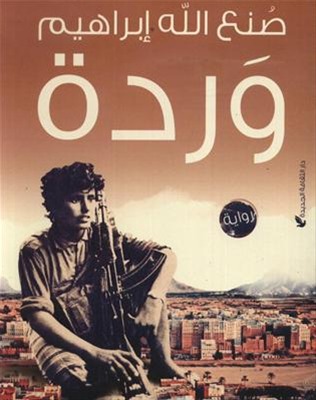Showing 3145–3156 of 3202 results
وثائق من عصر النبوة والخلافة
4.000 KD
وجع بلاقرار
3.250 KD
هي رواية للأسير الفلسطيني كَميل أبو حنيش، تعتبر من أدب السجون، كتبها الأسير خلال فترة اعتقاله الذي امتد من عام (2003) إلى يومنا هذا وحُكم عليه بتسع مؤبدات، تناولت الرواية أعمال المقاومة والتنظيم ، وانفجار الانتفاضتين الأولى عام (1987) والانتفاضة الثانية عام (2000)، مبينًا النقلة النوعية للمقاومة خلال الفترتين وتنامي الحس الوطني والتربية العسكرية التنظيمية لدى المقاوم وتطور أدواته، وعكس واقع الأسير في سجون الاحتلال مصورًا السجن وأدواته وأركانه، والسجان وجبروته وتعنته ، والانفعالات النفسية الظاهرة في شخصه كراوي وفي شخصية "علاء" الراوي الآخر الذي تبرز صورته في الرواية، فيها من صدق المشاعر ما يستحق الدراسة، تعرض الرواية قصة علاء الأسير الذي عانى الفقد بكل أركانه، فقد الأم، فقد الحرية، فقد الحبيبة وكانت أوجاعه بلا قرار.
وجع بلا قرار هي رواية أم تحمل في بطنها رواية أخرى، فيظهر راويان، الأسير ذاته تجربته النضالية، والمقاومة، والمطاردة، الى حين الاعتقال وحيثيات السجن وقصة الحب المفقود للمحبوبة" جنان" ، ورواية الانسان الغامض في البداية ، الذي لا يلبث أن يتحول الى صديق حميم، "علاء" الذي يقدّم روايته من خلال كتاباته التي تفضح مكنون ذاته يزهر وجعه على جرح رفيقه فتشعر أن الراوي شخص واحد يتردد صداه في عمق كل أسير.
تظهر لغة الرواية الفرق بين السجن من وجهة نظر السجين والسجان، وتعمد إلى الافضاء الى الشاعرية حين يغمر الكلمات حزن معتق يفيض من أعماق الروح، فنجد أنّ النص المنتمي لأدب السجون نص غنائي جدير بالتأمل يؤرخ لأحداث ويصور معاناة الأسرى بعين خبير ويتركك على تماس مع الحكاية الفلسطينية .
تجلى في الرواية صدى الأساطير القديمة كأسطورة العنقاء التي تمثل الصمود والتجدد والبقاء
وجوه خبيئة : الموت في الحب
5.000 KD
لكأن اللغة العبقرية الإبداعية الاستثنائية لهذا الفنان العالمي سيلفادور دالي، لم تكتفِ بما شكّلت من العالم المعذب ذي القوانين والمثيولوجيات والأوهام والتحولات الخاصة، فإذا بالفنان يصير كاتباً، وأيّ كاتب! تلك هي (سولانج دي كليدا) تسمق من هذه الرواية لتكون واحدة من أبرز الشخصيات الروائية اللواتي خلّدهنّ التاريخ. إنها المرأة التي يحترق أبيقور وأفلاطون في شعلتها من الغموض الأنثوي الأبدي. وكما صاغ سيلفادور دالي (الكليدالية) من هذه الشخصية، تعبيراً عن اللذة والألم، صاغ من الحب والموت عالماً روائياً، كأنما يؤلف الأوبرا التي خطط لتأليفهها هو وفيديريكو غارسيا لوركا، كلن لوركا (طار)، وحمل دالي العهد حتى أوفاه برؤية أوبرالية، يندمج فيها التشويش الإيديولجي والأساطير والشهوات والسموّ والوضاعة والوفاء.
الموضوع الرئيسي لهذه الرواية هو (الموت في الحب). ويقدم دالي فيها معالجة عصرية لأسطورة تريستاة وإيسولدة الخالدة، حيث لا شيء يعطي حدّة أكبر للحب من الموت الوشيك، ولا شيء يعطي حدّة أكثر للموت من عبوديته التي لا علاج لها للحب. لكن تمت في هذه الرواية موازنة موضوع الموت بنقيضه: القيامة. فبعثُ حياة جديدة من التفسّخ والدمار يستمرّ طوال الرواية، ورمزه الروائي من البداية هو غابة البلوط التي تنعم كل ربيع ببراعم خضراء مصفرة.
وحدة العقل العربي الإسلامي
5.000 KD
يقوم كل مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، على اصطناع "قطيعة معرفية" بين فكر المشرق وفكر المغرب، وعلى التمييز بين "مدرسة مشرقية إشراقية ومدرسة مغربية برهانية"، وعلى التوكيد أن رواد "المشروع الثقافي الأندلسي ـ المغربي" ـ ابن حزم وابن طفيل وابن رشد وابن مضاء القرطبي والشاطبي ـ تحركوا جميعهم في اتجاه واحد هو "اتجاه رد بضاعة المشرق إلى المشرق"، و"الكف عن تقليد المشارقة"، و"تأسيس ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة أهل المشرق". هذا الجزء الثالث من مشروع طرابيشي لـ"نقد نقد العقل العربي" يتصدّى لتفكيك تلك "الإبستمولوجيا الجغرافية" من منطلق توكيد وحدة بنية العقل العربي الإسلامي، ووحدة النظام المعرفي الذي ينتمي إليه بجناحيه المشرقي والمغربي، ووحدة المركز الذي تفرّعت عنه دوائره المحيطة. فلا التحوّل من دائرة البيان إلى دائرة العرفان أو دائرة البرهان، يعني انعتاقاً من جاذبية نقطة المركز، ولا التنقل بين الخانات يمكن أن يكون خروجاً عن رقعة شطرنج العقل العربي الإسلامي الذي يبقى يصدر عن نظام إبتسمي واحد مهما تمايزت عبقريات الأشخاص وعبقريات الأماكن. هذا الكتاب، إذ يرفض التوظيف الأيديولوجي الإقليمي لمفهوم القطيعة الإبتسمولوجية، يتوسّل حفريات المعرفة الحديثة ليعيد بناء وحدة الفضاء العقلي للتراث العربي الإسلامي، وليقترح قراءة اتصالية – لا انقطاعية – للإسهامات المميزة للمدرسة الأندلسية، سواء أتمثلت في مقاصدية الشاطبي، أم عرفانية ابن طفيل، أم الانتفاضة النحوية لابن مضاء القرطبي. وهذا، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف "الفلسفة المشرقية" لابن سينا واقتراح حل جديد للغزها.
وحدها شجرة الرمان
4.000 KD
تنفتح رواية الكاتب العراقي سنان أنطون وحدها شجرة الرمان بسردية حكائية بسيطة تفاجئك احياناً بانعطافاتها إلى صور حلمية فنتازية، متقطّعة بحسب خطوات السيناريو السينمائي، على مشهديات الموت الذي يلتهم قلب بغداد المحتلة، والذي يظل ماثلاً أمام ناظري جواد الذي يمتهن غسل الأموات وتكفينهم، بعد أن تعلّم أصول المهنة ومبادئها وأسرارها على يدي ابيه. وهي مهنة توارثتها العائلة منذ زمن بعيد.
غسل الموتى هذا كان يجري قبل الاحتلال الأميركي للعراق على رسله وطبيعته المعتادة. بوطأة الحرب الضروس، والاقتتال بين أبناء البلد الواحد جماعات وأفراداً، ازدادت وتيرة القتل ازدياداً ملحوظاً، واتخذ شكل الموت ضروباً مروعة من التمثيل بالجثث والتنكيل بها، طعناً وخنقاً وحرقاً وبقراً وتقطيعاً.
وقد وصل الأمر بجواد انه تبلبل واحتار بكيفية غسل رأس مقطوع بلا جثة، وجسد قُطّع بمنشار كهربائي غسلاً طقوسياً يفترضه الشرع الإسلامي قبل الدفن.
سنان أنطون
دار الجمل
وحوش أرض صغيرة
6.500 KD
قصة ملحمية عن الحب والحرب والتضحية تدو أحداثها على خلفية حركة الاستقلال الكورية، تصور المصير المشترك الذي جمع فتاة صغيرة بيعت لمدرسة المحظيات وابن صياد مفلس.
في عام ١٩١٧، في أعماق الجبال الثلجية في كرويا المحتلة، ينقذ صياد محلي فثير على شفا الموت من الجوع ضابطًا يابانيًا شابًا من نمر مهاجم. في لحظة، تتشابك مصائرهما ـ ومن هذه المواجهة تنكشف قصة تمتد لنصف قرن.
نادي الكتاب العربي
وحي القلم : ثلاثة أجزاء
10.000 KD
وحي القلم من أروع ما أبدع الرافعي وأجمل
ما خطت أنامل ذلك الأديب اللامع، فهو من
رواد البيان وأصحاب اللغة الرفيعة واللفظ
العذب، امتلك ناصية اللغة وطَوَّعَ قلمه ليكون
صوتًا يصدع بالحق، وسلاحًا بتَّارا يمحق
الباطل، ويذود به عن عرين اللغة، وينافح عن
القرآن بما أتاه الله من حُجة بالغة وبيان ساطع
وإلمام بالتراث الأدبي.
إنه عمل راق يعالج أدواء اجتماعية لها صدى
واسع في حياتنا المعاصرة وواقعنا المعاش، بل
هو بستان من بساتين الرافعي الوارفة المثمرة،
وما أحوج قارئ اليوم أن يجتني من ثمره
ويرتشف من رحيقه ويتفيأ ظلاله.
المؤلف : مصطفى لطفى المنفلوطى
وداعا الإسكندرية التي تفقدها
2.500 KD
"وداعاً للإسكندرية التي تفقدها" مئة وعشرون قصيدة جاءت من ترجمة "سعدي يوسف" للشاعر اليوناني "قسطنطين كافافي" المولود في الإسكندرية سنة 1863، والمتوفى فيها سنة 1933م.
اتبع "كافافي" في شعره مسارب التاريخ القديم وطعمة بحس جمالي، حيث وجدت مخيلته في التآلف الهلينستي للحضارات والأجناس، في مدن كالإسكندرية وأنطاكية حيث يشكل الأغريقي والوثني والمسيحي والفيلسوف والقسيس والبربري محوراً لقصائده، يقول "سعدي يوسف" في مقدمة الكتاب "... ما الذي منح كافافي هذه القدرة على تقديم شعر بهذا الكمال، وبنفاذ البصيرة هذه؟.
لقد أعانه بالتأكيد، إكتشافه ما يرقى إلى ميثولوجيا شخصية: شخصيات متخيلة، أو حقيقية، في الساعة الهللينستية في آسيا، أو مقدونيا، أو مصر، هيأت له (كما أشار س.م. بورا) رموزاً ملائمة لعبقريته، شأن ميثولوجيا إيرلندة القديمة بالنسبة للييش، أو حكايات "الكأس القديمة" بالنسبة لأليوت في قصيدة "الأرض الخراب" لقد تهيأت لكافافي نظرة حديثة وفريدة إلى العالم...
يقول في قصيدة بعنوان [لم تفهم] "عن آرائنا الدينية... قال جوليان الغبي: "قرأت، فهمت، أدنتُ"... لكأنه أباءنا بكلمته "أدنتُ" هذا الهزأة مثل هذا الحذف لم يمرّ بيننا، نحن المسيحيين... "قرأت، لكنك لم تفهم... إذ لو فهمتَ لما أدنتَ... هكذا أحببناه، فوراً"