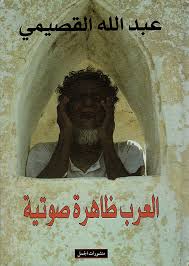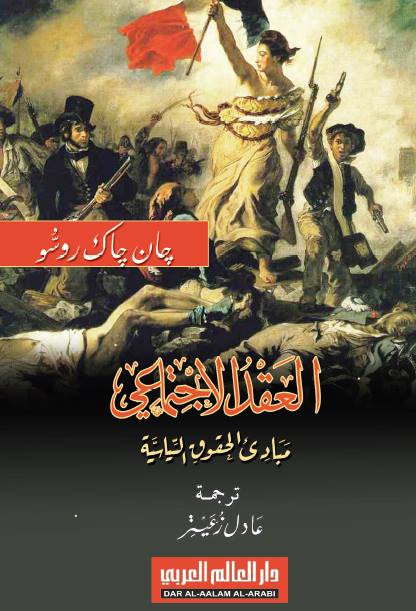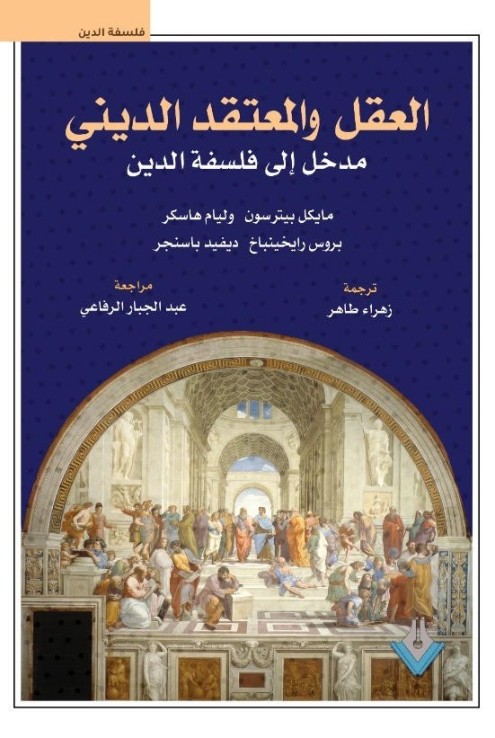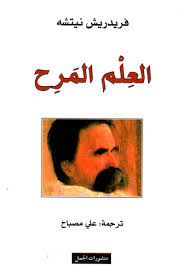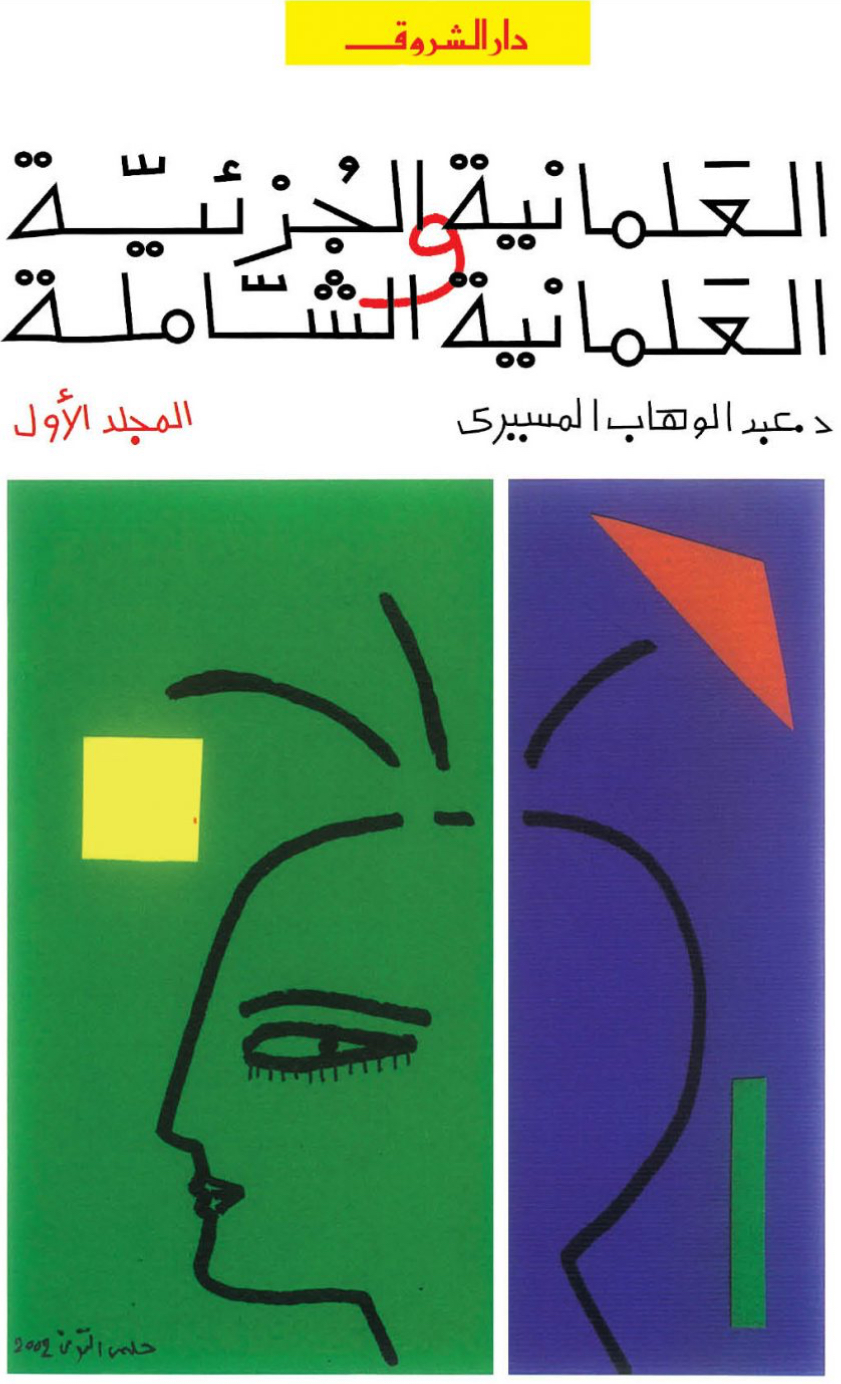Showing 121–132 of 481 results
العالم من منظور غربي
العالم من منظور غربي"محاولة لمناقشة قضية منهجية وفكرية شديدة الأهمية، يطرحها الدكتور "عبد الوهاب المسيري".فمنذ نهاية القرن الثامن عشر، بدأ ما يسمى "الغزو الثقافي"، وهو محاولة الإنسان الغربي فرض نماذجه على شعوب العالم. وهي نماذج أثبتت نفعها في العالم الغربي في المجالات الاقتصادية والسياسية، ولكنها لها جوانبها المظلمة والمدمرة في مجالات أخرى.
إن لكل مجتمع تحيزاته، ولكن ما حدث هو أن كثيرًا من شعوب العالم بدأت تتخلى عن تحيزاتها النابعة من واقعها التاريخي والإنساني والوجودي، وبدأت تتبنى التحيزات الغربية، فبدأت تنظر لنفسها من وجهة نظر الغرب. ينقسم هذا الكتاب إلى جزئين، في الجزء الأول يناقش المسيري قضية التحيز مستعرضًا التحيز للنموذج المعرفي المادي المرتبط بالحضارة الغربية الحديثة. ويحاول في الجزء الثاني تقديم النموذج البديل.
يدق الدكتور عبد الوهاب المسيري ناقوس خطر مبكر، لأننا إن لم ننتبه لخطورة الغزوة الحضارية التي تقوضنا من الداخل والخارج وتقضي على هويتنا وعلى أشكالنا الحضارية ومنظوماتنا المعرفية والقيمية، فربما قد يتحقق لنا البقاء لا ككيان متماسك له هوية محددة، وإنما كقشرة خارجية لا مضمون لها. "