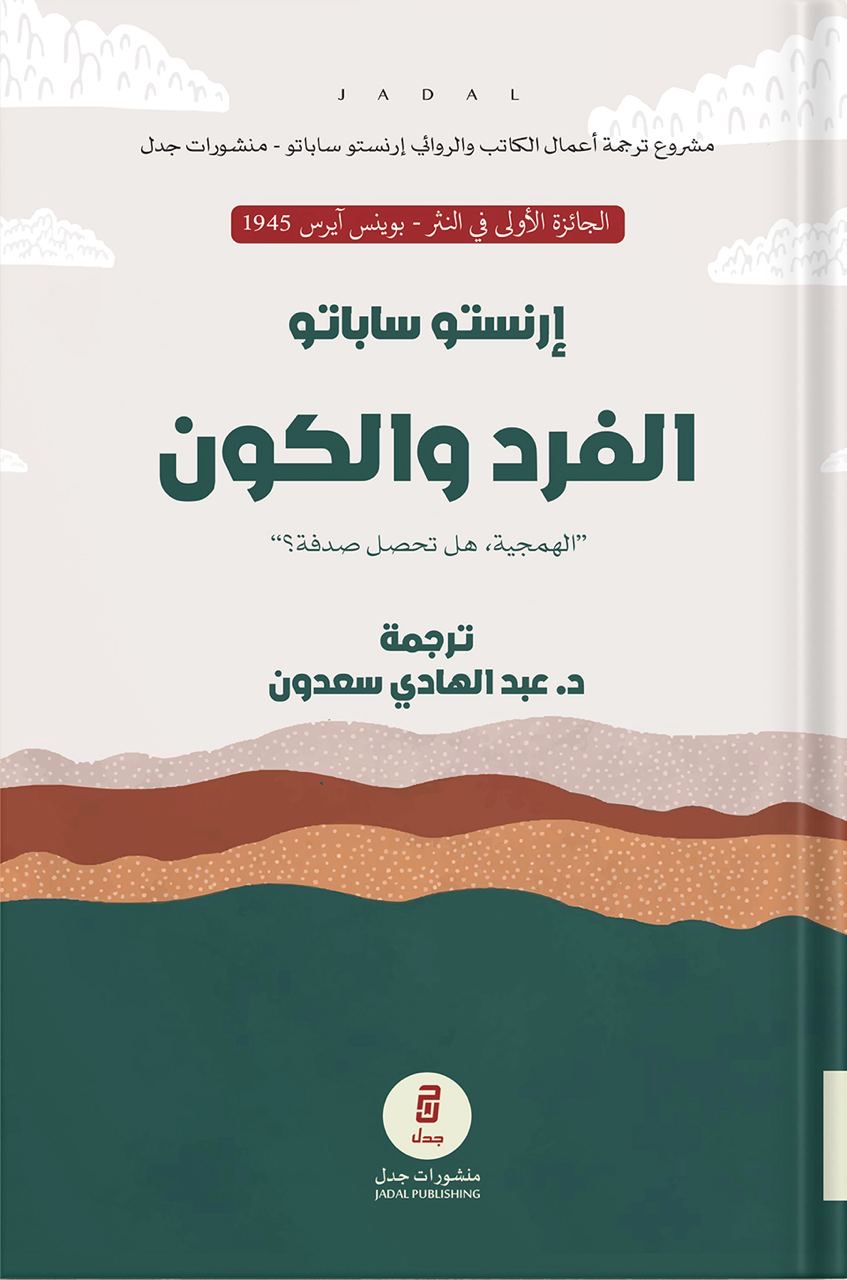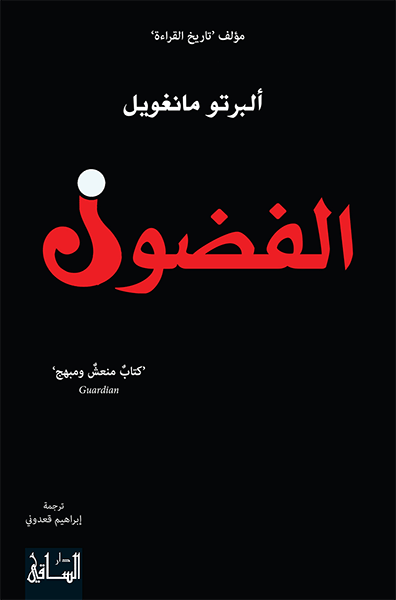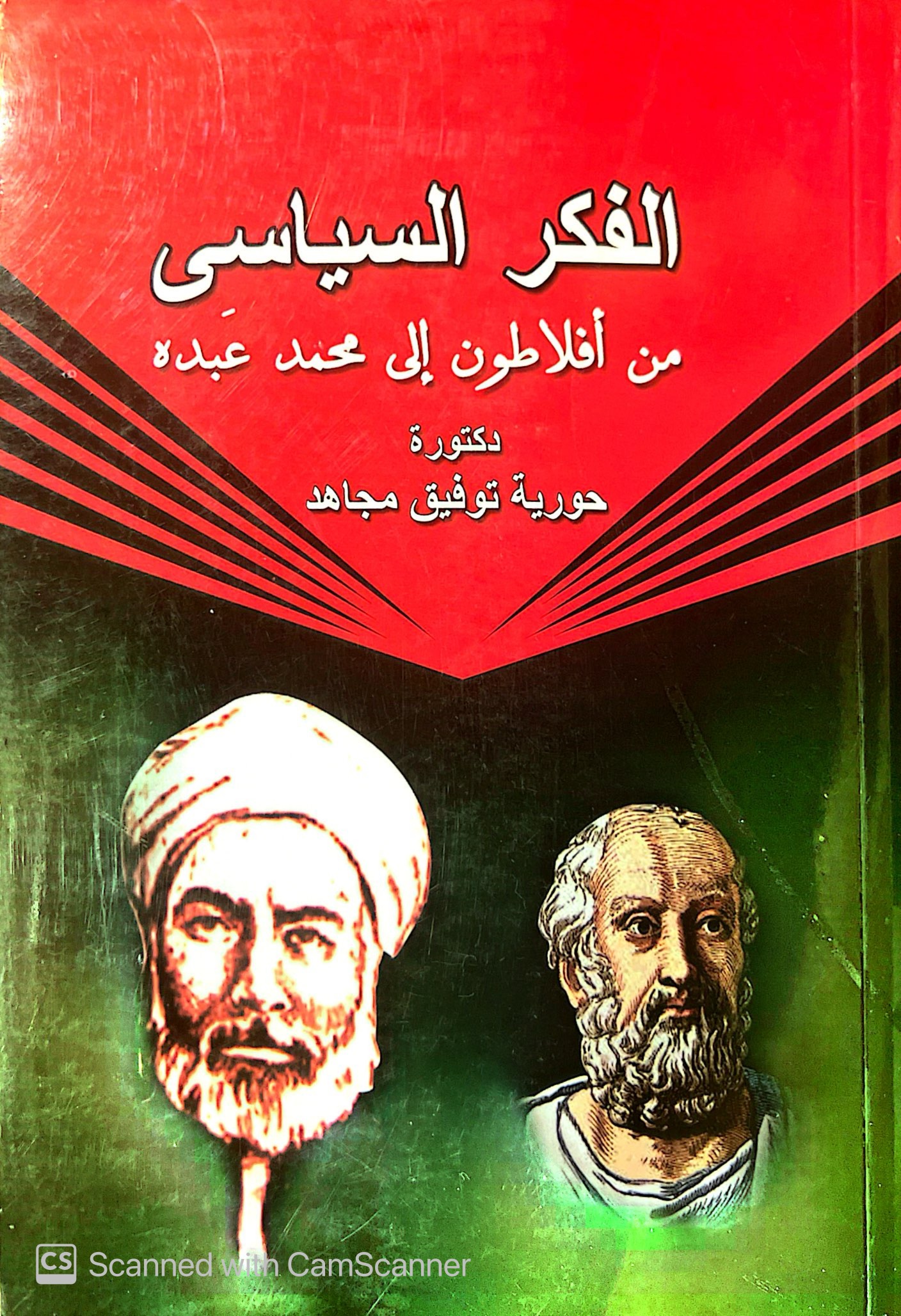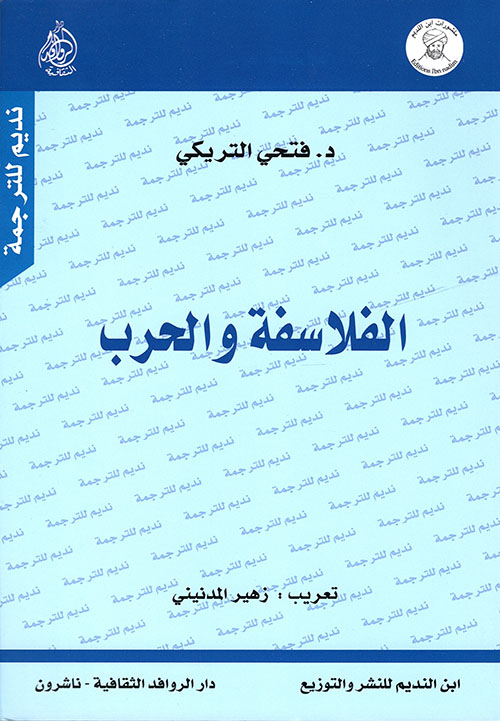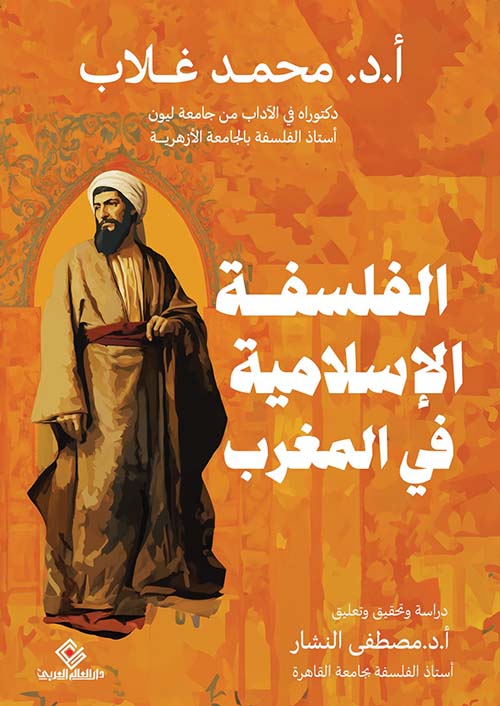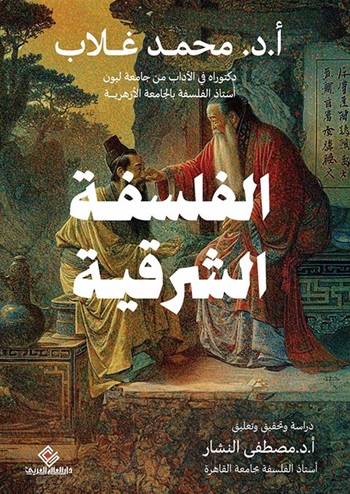Showing 133–144 of 481 results
الفرد والكون : الهمجية هل تحصل صدفة؟
3.000 KD
«الفرد والكون» كتاب مقالات للروائي الأرجنتيني المعروف أرنستو ساباتو (1911ـ2011)، وقد نُشرتطبعته الأولى عام 1945، وفي العام نفسه حصل عن كتابه هذا على الجائزة الأولى في النثر من بلدية بوينس آيرس. وهذا الكتاب، على الرغم من أنه ليس أهم كتب ساباتو المعروفة، ولا سيما رواياته، مثل: النفق 1948، وعن الأبطال والقبور 1961، يشكّل العمود الفقري الأساس لفهم آرائه ومعتقداته الفكرية والثقافية، التي يبثها في هذا الكتاب وكتب نقدية تحليلية أخرى مثل: الكاتب وأشباحه 1963، وقبل النهاية 1993. يتعامل الكتاب، بشكلٍ أساسيٍّ، مع الحقائق الاجتماعية والفلسفية الموروثة، وكيفية تأثيرها على الفرد، الذي يعيش تحولات القرن العشرين بكل حركاتها الفنية والثقافية والنفسية. يعبر المؤلف عن بحثه الدائم عن الإنسان وقيمته الحقيقية، وينتقد الأخلاق الحيادية للعلم. يتناول في المقالات موضوعات مثل: اكتشاف أمريكا والعلم والفضاء والرغبات الإنسانية ونظرية النسبية، وشخصيات فنية وأدبية معاصرة وكلاسيكية، كما أنه يتحدث، بشكل مكثف، عن مؤلفين مثل: أرسطو ونيوتن وغاليليووبورخيس، وصولاً إلى السريالية، وهي حركة فنية وأدبية شارك فيها ساباتو نفسه عندما كان يعمل ويعيش في باريس. والمؤلف أرنستو ساباتو يعلّق، في مقدمة الكتاب، عن هذه المقالات المجموعة قائلاً:“الآراء التي تظهر هنا بالترتيب الأبجدي ليست نتاج تأمل متقاعس لـ العالم، بل تشير إلى الكيانات التي وجدتها في طريقي إلى نفسي. (يتجه المرء نحو الأراضي البعيدة، أو لطلب المعرفة البشرية، أو لمعرفة ماهية الطبيعة، أو البحث عن الرب؛ ثم يلاحظ أن الشبح الذي كان يطارده هو ذاته نفسها). خارج طريقي يجب أن تكون هناك كيانات أخرى، نظريات وفرضيات أخرى. الكون الذي نتحدث عنه هنا هو عالمي الخاص، وبالتالي هو غير مكتمل ومتناقض ومثالي“.
عدد الصفحات: ١٢٤
الفلاسفة والحب
3.500 KD
الحب، ذلك الشعور المبهج بين كافة المشاعر الأخرى، يبدو صامداً في مواجهة الأفكار التي عبرت القرن الماضي، والتي حصرت الحب في الجنس: حبٌّ لطيفٌ ومرِحٌ ولا يتضمن أيّ تحديات حقيقية. " يقولون إنه ما من تآلف بين الفلاسفة والحب!"
أيعني ذلك أن الكثير من الفلاسفة لم يختبروا الحب؟ كلا فيما يبدو، وهذه هي قضية هذا الكتاب. وهي محاولة متواضعة للنظر في هذه النقطة بعدالة على طريقتهم المرتبكة، أو المختالة، واللاذعة في معظم الأحيان، بل والعدائية الشرسة التي انتهجها بعضهم، والحديث عن كل ذلك بلهجة حاسمة.
فجميعهم في الحقيقة لديهم ما يقولونه لنا عن الحب، وعما يصاحبه من وَهْمٍ بالخلود، وما يولّده من معاناة، وعن الطريقة التي نطمح بها لترويضه. إن دونجوانية سارتر الوسواسيّة، أو الغياب الاسطوري للرغبة عند كانط، أو الفشل الذريع المتكرر لنيتشة مع الفتيات الشابات، تعَدّ جميعها حلقات صادمة أو غريبة يستطيع كل منّا استخلاص دروس منها وتطبيقها على حياته الخاصة
الفلاسفة والحب
ماري لومنييه, اود لانسولان
دار التنوير
الفلاسفة والحرب
3.500 KD
فلسفة الحرب هي مجال الفلسفة المكرس لدراسة قضايا مثل أسباب الحرب، والعلاقة بين الحرب والطبيعة البشرية، وأخلاقيات الحرب. تتداخل بعض جوانب فلسفة الحرب مع فلسفة التاريخ والفلسفة السياسية والعلاقات الدولية وفلسفة القانون.
أعمال حول فلسفة الحرب
ربما كان العمل الأعظم والأكثر تأثيرًا حول فلسفة الحرب هو عمل كارل فون كلاوزفيتز عن الحرب، فهو يجمع بين الملاحظات على الاستراتيجية مع إثارته أسئلةً حول الطبيعة البشرية والغرض من الحرب. يمعن كلاوزفيتز النظر بالتحديد في غوغائية الحرب: هل كانت الحرب وسيلة للوصول إلى النهاية خارج نفسها أم أنها قد تكون النهاية في حد ذاتها. ويخلص إلى أن الاحتمال الأخير لا يمكن أن يكون صحيحًا، وأن الحرب هي «سياسة بوسائل مختلفة»؛ بمعنى أن هذه الحرب يجب ألا تكون موجودة فقط من أجل الحرب. يجب أن تخدم بعض الأغراض للدولة.
تحتوي رواية ليو تولستوي الحرب والسلام على انطباعات فلسفية متكررة حول فلسفة الحرب (والتكهنات الميتافيزيقية الأوسع المستمدة من المسيحية وملاحظات تولستوي للحروب النابليونية). كان لها تأثير على الفكر اللاحق للحرب. كان لفلسفة تولستوي للحرب المتمحورة حول المسيحية (وخاصة مقالاته «رسالة إلى هندوسي» و«مملكة الرب بداخلك») تأثيرٌ مباشرٌ على فلسفة غاندي المتمحورة حول الهندوسية والتي تتبنى المقاومة السلمية.
في حين يركز عمل سون تزو فن الحرب في الغالب على الأسلحة والاستراتيجية بدلًا من الفلسفة، تُوسَّع ملاحظاته غالبًا إلى فلسفة مطبقة في مواقف تمتد إلى ما بعد الحرب نفسها. تناقش أجزاء من تحفة نيكولو مكيافيلي الأمير (وأيضًا نقاشات حول ليفي) وأجزاء من عمله هو الآخر المُسمّى فن الحرب بعض النقاط الفلسفية المتعلقة بالحرب، رغم عدم إمكانية القول إن أي كتاب مما ذُكر كان عملًا يختص في فلسفة الحرب.
نظرية الحرب العادلة
تقدم الملحمة الهندوسية الهندية، ماهابهاراتا، أول مناقشات مكتوبة حول «الحرب العادلة» (دارما يودها أو «الحرب الصالحة»). في ذلك، يسأل أحد الإخوة الحاكمين الخمسة (باندافا) ما إذا كان من الممكن تبرير المعاناة التي تسببها الحرب. ثم يتلو ذلك نقاش طويل بين الأشقاء، واضعين معايير مثل التناسبية (لا يمكن للعربات مهاجمة الفرسان، بل العربات الأخرى فقط؛ لا تجوز مهاجمة الأشخاص الذين يعيشون في ضائقة)، والأساليب العادلة (لا يُسمح بالسهام المسمومة أو الشائكة)، والسبب العادل (لا تهاجم بدافع الغضب)، والمعاملة العادلة للأسرى والجرحى. تنص فلسفة الحرب العادلة على ماهية جوانب الحرب التي يمكن تبريرها وفقًا لمبادئ مقبولة أخلاقيًا. تستند نظرية الحرب العادلة إلى أربعة معايير أساسية يتّبعها أولئك المصممون على الذهاب إلى الحرب. المبادئ الأربعة هي كما يلي: السلطة العادلة، والسبب العادل، والنية السليمة، والحل الأخير.
السلطة العادلة
يشير معيار السلطة العادلة إلى شرعية العزم على الذهاب إلى الحرب، هل عُولج مفهوم الحرب والسعي خلفها وبُرّر قانونيًا؟
السبب العادل
السبب العادل هو سبب مبرر لأن الحرب هي الرد المناسب والضروري. إذا كان من الممكن تجنب الحرب، فيجب تحديد ذلك أولًا، وفقًا لفلسفة نظرية الحرب العادلة.
النية السليمة
للذهاب إلى الحرب، يجب تحديد ما إذا كانت نوايا القيام بذلك سليمةً وفقا للأخلاق. يتطلب معيار النية السليمة تحديد ما إذا كانت استجابةُ الحرب طريقةً يمكن قياسها نسبةً إلى النزاع الذي يجري التعامل معه أم لا.
الحل الأخير
الحرب هي الملاذ الأخير، بمعنى أنه إذا كان هناك نزاعٌ بين الأطراف المتعارضة، فيجب تجريب جميع الحلول قبل اللجوء إلى الحرب.
تقاليد الفكر
نظرًا إلى أن فلسفة الحرب تُعامل غالبًا على أنها مجموعة فرعية من فرع آخر من الفلسفة (على سبيل المثال، الفلسفة السياسية أو فلسفة القانون)، سيكون من الصعب تحديد أي مدارس فكرية واضحة بالمعنى نفسه، على سبيل المثال، يمكن وصف الوجودية أو الموضوعية بأنهما حركتان منفصلتان. تشير موسوعة ستانفورد للفلسفة إلى أن كارل فون كلوزويتز هو «الفيلسوف الوحيد للحرب» (كما يُقال)، ما يعني أنه الكاتب الفلسفي (الرائد) الوحيد الذي يطور نظامًا فلسفيًا يركز حصريًا على الحرب. ومع ذلك، فقد تطورت تقاليد الفكر الملموسة حول الحرب مع مرور الوقت، حتى تمكن بعض الكتاب من التمييز بين الفئات الواسعة (حتى ولو كان ذلك غير دقيق إلى حد ما).
عدد الصفحات :208
الفلسفة الإلهية في كتاب مقاصد الغزالي : قراءة تحليلية لنص فلسفي
4.500 KD
“أما بعد فإني التمست كلاماً شافياً عن تهافت الفلاسفة وتناقض آرائهم ومكامن تلبيسهم وأغوائهم، ولا مطمع في إسعافك إلاّ بعد تعريفك مذهبهم، وإعلامك معتقدهم، فإن الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها، مُحال بل هو رمي في العماية والظلال، فرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلاماً وجيزاً مشتملاً على حكاية مقاصدهم، من علومهم (المنطقية) و(الطبيعية) و(الإلهية) من غير تميز بين الحق منها والباطل بل لا أقصد ألا تفهم غاية كلامهم من غير تطويل يذكر ما يجري الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد، وأورده على سبيل الإقتصاص والحكاية مقروناً بما أعتقده أدلة لهم ومقصود الكتاب حكاية مقاصد الفلاسفة وهو اسمه حتى إذا فرعنا منه استأنفنا له جداً وتشميراً في كتاب مفرد نسميه تهافت الفلاسفة إن شاء الله تعالى. – من كتاب المقاصد يأتي بحثنا هذا لتأصيل قسم من هذا الكتاب عند الفارابي وابن سينا، أي إرجاعه إلى منابعه الأصلية والكشف بشكل علمي على مدى صحة ما ورد في مقدمته، وبيان مدى أمانة الغزالي في نقل علوم الفلاسفة، ومدى تصرفه في التدوين، هل نقل زبدة القول بعد هضمه وتمثله أم نقل نصوصاً كما هي؟ وما هي الكتب التي كان تركيز الغزالي منصب عليها؟. وعموماً يمكن القول أننا سنحاول في هذا البحث أن نضع “إلهيات المقاصد” بلسان الفلاسفة (الفارابي وابن سينا) أي بالرجوع إلى كتبهم، والبحث عن نصوص المقاصد فيها، وهو فضلاً عن التأصيل، عرض للفلسفة الإلهية عند الفارابي وابن سينا، ومع ذلك فإن ما سنختاره من نصوص سواء أكانت من الفارابي أو ابن سينا، لا يعني أن هذه النصوص اختارها الغزالي فعلاً ولخّصها لأننا سنلاحظ أن هنالك كثيراً من النصوص المتقاربة وسنجد صعوبة في إختيار النص القريب وهذا ما تختلف فيه آراء الباحثين، لذلك سنحاول إختيار النص الأقرب بقدر الإمكان.
الفلسفة الرواقية
4.500 KD
عثمان أمين من أساتذة قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وقد استخلص فلسفةً خاصة ابتكرها وأطلق عليها ”الجوانية”، اهتدى إليها بعد إطالة النظر في أمور النفس، ومتابعة التأمل في بطون الكتب مع مداومة التعرض لتجربة الواقع والمعاناة لشؤون الناس.
وكان بعد حصوله على الليسانس من جامعة القاهرة أن سافر إلى باريس في بعثة دراسية أرسلتها كلية الآداب لدراسة الدكتوراه بجامعة السربون، وقضى هناك نحو سبع سنوات كان خلالها جاداً دائماً، نهل من موارد البحث والدرس ما وسعه الجهد، فقد قرأ في الأدب والفن. كما قرأ في العلم والفلسفة، وتابع كبار الأساتذة، وجوّد لغته الفرنسية إلى جانب الإنجليزية، وضم إليها حظاً غير قليل من اليونانية واللاتينية.
له العديد من المؤلفات الهامة: مثل ديكارت، الفلسفة الروائية، رائد الفكر المصري محمد عبده، شخصيات ومذاهب إسلامية، محاولات فلسفية، شيلر، رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي، كما ترجم عدة كتب من نفائس الفلسفة الغربية.
عدد الصفحات : ٢٨٥
الفلسفة السياسية في العهد السقراطي
3.750 KD
إن ما يطرحه العهد السقراطي من مقولات على قاعدة جدلية الفكر والمجتمع يؤكد توق الشعوب، في مسارها الحضاري والعلمي والثقافي، إلى ما يلبّي حاجات أفرادها ويعزز مؤسسات الدولة بارتكازها على القوانين العادلة والدساتير التي توفر الاستقرار والانسجام والتوازن في المجتمع الواحد.
بنى العهد السقراطي الدولة على القيم والأخلاق والفضيلة والحس القومي، المقوّمات التي استقى منها الغرب الأوروبي فكره من أجل النهوض القومي.
ويتساءل المؤلف في هذا الكتاب إلى أي حد تتطابق المبادئ الأساسية التي وضعها العهد السقراطي مع تباشير العولمة التي تجتاح العالم، والتي تعدنا بمستقبل أفضل للبشرية وبفردوس أرضي جديد؟ هل العودة إلى حب السلطة واللذة والمال هي الأفضل لحكم الشعوب ولسياستها في القرن الحادي والعشرين؟ وهل تقود العولمة إلى الحوار أم هي تغذي صدام الحضارات؟
ريمون غوش حائز دكتوراه دولة في الفلسفة من جامعة السوربون الأولى بدرجة مشرف جداً.أستاذ الفلسفة اليونانية والمنطق ومناهج البحث الفلسفي وعلم الجمال، وعضو في لجنة قبول مشاريع الدكتوراه لطلاب الفلسفة، وعضو لجنة إدارة البحث العلمي في المعهد العالي للدكتوراه، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.
عدد الصفحات : ٢٠٠
الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين
4.000 KD
مؤلف هذا الكتاب هو الباحث آلان شريفت المختص بتاريخ الفلسفة الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص. وهو يقدم هنا بانوراما شاملة عن تيارات الفلسفة الفرنسية على مدار القرن العشرين. انتقد ذاتية سارتر المفرطة وموضوعية ليفي ستروس الباردة ودعا إلى اتباع خط وسطي يجمع بين الذاتية والموضوعية. وأنقذ بذلك الفلسفة الفرنسية من خطر التطرف في هذا الاتجاه أو ذاك. أما لويس التوسير فقد حاول أن يطبق مفهوم القطيعة الابستمولوجية على فكر ماركس عن طريق القول بأن هناك قطيعة جذرية بين أعمال ماركس الشاب وأعمال ماركس الناضج، وهذا يعني أن ماركس انتقل من عهد الأيديولوجيا إلى عهد الابستمولوجيا والعلمية الكاملة بعد أن نضج فكرياً. ولكن هذه النظرية التي عرضها في شرحه لكتاب الرأسمال وفي كتابه «من أجل ماركس» لم تقنع بعضهم على الرغم من الرواج الكبير الذي حظيت به في الستينات. والواقع أن فلسفة التوسير تعاني من نقاط ضعف عديدة على الرغم من أهمية بعض أعماله وكتاباته، وأهم نقطة ضعف لديه هي تضخيمه لأهمية ماركس حتى لكأنه شخص معصوم تقريباً.وهذا الخطأ وقع فيه العديد من المثقفين الماركسيين في شتى أنحاء العالم وليس فقط في فرنسا. ثم يتوقف المؤلف عند فلاسفة آخرين عديدين كجان هيبوليت الذي أمضى حياته في ترجمة هيغل ونقل أفكاره إلى اللغة الفرنسية، وكان من المساهمين في بلورة التيار الظاهراتي أو الفينومينولوجي في الفلسفة الفرنسية. وهناك أيضاً بول ريكو الذي مات هذا العام عن عمر يناهز التسعين بعد أن بلور فلسفة كاملة عن الإنسان والمجتمع والدين والسياسة. وكان من الداعين إلى تفسير الدين بشكل عقلاني جديد لكي نخرج من جحيم التعصب وظلامية المتعصبين الضيقي الأفق.