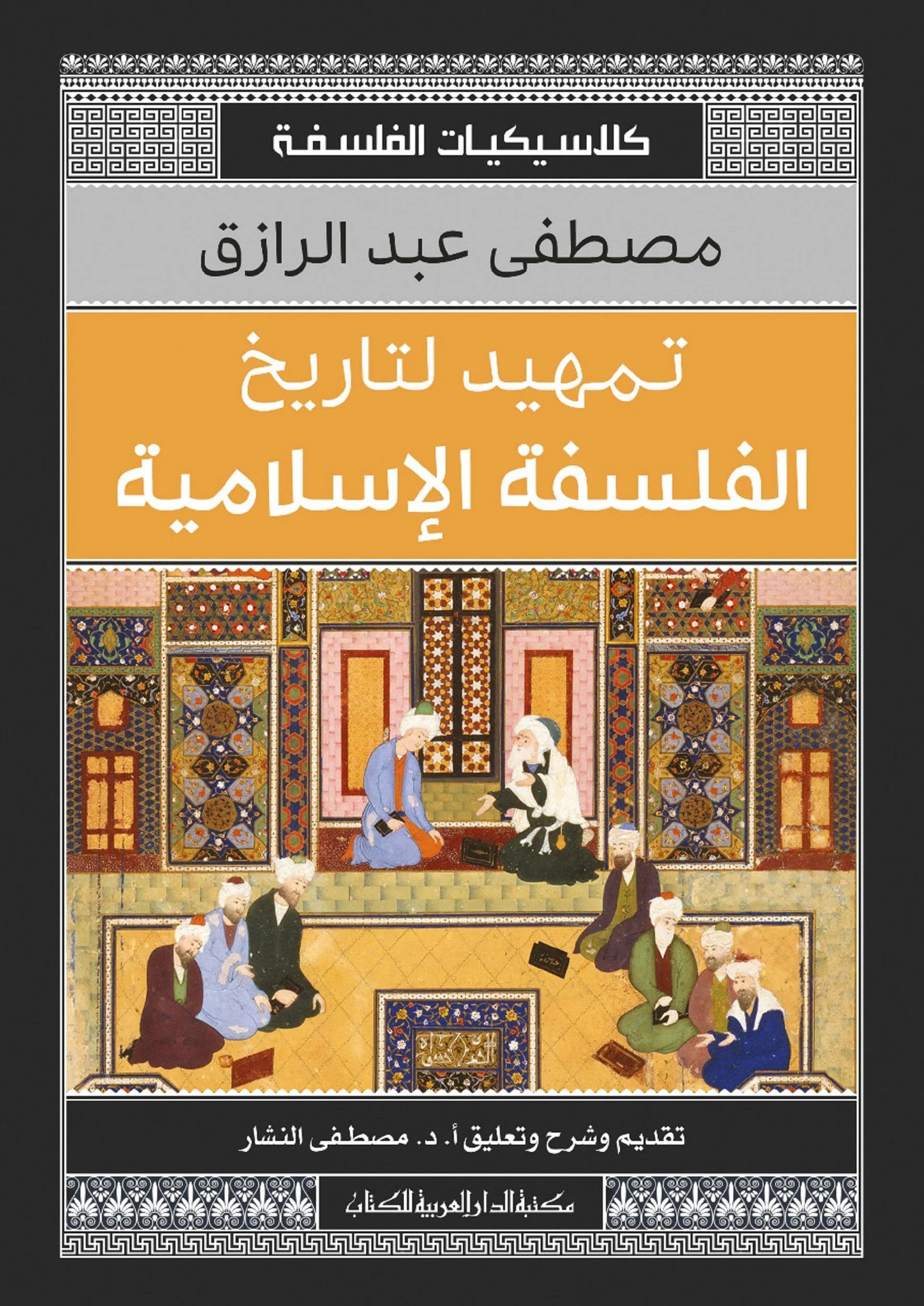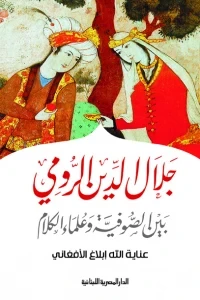Showing 241–252 of 481 results
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
4.000 KD
إن هذه السلسلة من كلاسيكيات الفلسفة تأليفًا وترجمة هي أبرز ما قامت عليه نهضتنا الحديثة، وهي ما تربت عليه الأجيال السابقة. وما أحوجنا اليوم لإعادة نشر هذه الكلاسيكيات من مؤلفات ومترجمات رائدة لتستفيد منها أجيالنا الشابة، وخاصة في ظل ندرة ما يكتبه المتخصصون المعاصرون في الفلسفة ومجالاتها المختلفة، وفي ظل غياب المنهج الفلسفي للتفكير في حياتنا المعاصرة، مما كان السبب المباشر لما نراه من تطرف وتعصب وجمود وعدم تقبل الآخر وفقدان القدرة على التحليل ونقد الأفكار. * هل الفلسفة حرام؟ ماذا يعني علم الكلام؟ ما المقصود بالرأي؟ ما علاقة المسلمين بالفلسفة؟ هل هناك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية؟ هل أيَّد الإسلامُ العقلَ؟ هل ظهر الرأي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اختلف الصحابة في الرأي؟ تساؤلات كثيرة يثيرها هذا الكتاب مجيبًا عليها علميًّا وتاريخيًّا مما يجعله أهم مرجع في الفلسفة الإسلامية؛ حيث يبدأ بآراء الغربيين، ويُثنّي بآراء الإسلاميين مُفصّلًا مناهجهم، ذاكرًا أعلامهم في النظر العقلي وأثر ذلك على العلوم الشرعية كعلم العقيدة، والفقه. «لابد للباحث في الفلسفة الإسلامية وتاريخها من الإلمام بمقالات من سبقوه في هذا الشأن؛ ليكون على بصيرة فيما يتخيره من وجهة النظر، وفيما يتحرى اجتنابه من أسباب الزلل
تهافت الفلاسفة
3.500 KD
تهافت الفلاسفة هو كتاب الإمام الغزالي اعتبر البعض هذا الكتاب ضربة لما وصفه البعض باستكبار الفلاسفة وادعائهم التوصل إلى الحقيقة في المسائل الغيبية بعقولهم، أعلن الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة فشل الفلسفة في إيجاد جواب لطبيعة الخالق وصرح أنه يجب أن تبقى مواضيع اهتمامات الفلسفة في المسائل القابلة للقياس والملاحظة مثل الطب والرياضيات والفلك واعتبر الغزالي محاولة الفلاسفة في إدراك شيء غير قابل للإدراك بحواس الإنسان منافيا لمفهوم الفلسفة أساسا.
لخص الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة إلى فكرة أنه من المستحيل تطبيق قوانين الجزء المرئي من الإنسان لفهم طبيعة الجزء المعنوي وعليه فإن الوسيلة المثلى لفهم الجانب الروحي يجب أن تتم بوسائل غير فيزيائية.
كان الغزالي أول الفلاسفة الذين أقاموا صلحا بين المنطق والعلوم الإسلامية حين بين أن أساسيات المنطق اليوناني يمكن أن تكون محايدة ومفصولة عن التصورات الميتافيزيقية اليونانية. توسع الغزالي في هذا الكتاب في شرح المنطق واستخدمه في علم أصول الفقه،، لكنه شن هجوما عنيفا على الرؤى الفلسفية للفلاسفة المسلمين المشائين الذين تبنوا الفلسفة اليونانية. اعتبر الغزالي محاولة الفلاسفة في إدراك شيء غير قابل للإدراك بحواس الإنسان منافيا لمفهوم الفلسفة من الأساس. رد عليه لاحقا ابن رشد في كتابه تهافت الفلاسفة
تهمة اليأس
3.000 KD
الخلود والانتحار، موقعُ المرأة وغزيرة الرّجل، السيكولوجيا البشرية ومعاناتها، سعادتها في هذا العالم: هذه النصوص المنتقاة لا تحمل في طيّاتها صرامة الأطروحات الفلسفية البحتة التي كتبها شوبنهاور، وإنّما هي تشريح للعالم كما رآه من عيون تلك الفلسفة البحتة؛ هي إسقاطات قناعاته على طريقة حياتنا الفاسدة، وتوجيه للطريقة التي ينبغي أن نعيش من خلالها، فكما يقول لنا: “الحكمة النظرية التي لا تمرس مثل الوردة المزدوجة، تبهجُ الآخرين بألوانها وعطرها الجميل، ولكنها تذوي وترحل بلا بذور”.
وسواء اتّفق القارئ أم اختلف مع شوبنهاور – وهناك الكثير ممّا يستحق الاختلاف معهُ – فإنّه ولا شك سيجدُ متعة في النّور الساطع الذي يسلطهُ شوبنهاور على حياتنا اليومية: نورٌ يشبهُ ما يستعمله الجراحون قبل أن يعملوا أيديهم في جسد العلل.
بين دفّتي هذا الكتاب ما يستحق التّشبع من هذا التنوير، حتّى لو اختلف القارئ حول ما يبدو جليّاً تحتَ هذا الضوء.
عدد الصفحات : ١٢٤
توما الأكويني
2.500 KD
من مقدّمة المؤلِّف: "من بوادر نهضة الفكر، في ربوع العربيّة، اقبال قرّائها على قادة الفكر، من أيّ لسان كانوا. ففي العربيّة اليوم أبحاث عن فلاسفة اليونان، وفلاسفة العرب، والفلاسفة المعاصرين، وفيها أيضًا مختارات معرّبه عن مشاهيرهم. ولا تطمح هذه المحاولة إلى أكثر من تعريف توما الأكوينيّ تعريفًا إجماليًّا سريعًا. لا يفي بما له على المفكّرين من فضل، ولا بما في المفكّرين إليه من شوق. ولكنّها محاولة أولى، قدّر الله أن تكون فاتحة، تبعث الرغبة في مزيد من العلم والتدقيق، فنفيد، كما أفاد غيرنا، من تراث كان ولا يزال، في بضاعة الفكر، من أصفى معدن".
ثورة الشباب
2.000 KD
الفرق بين (( الثورة )) و (( الهوجة )) هو أن (( الهوجة )) تقتلع الصالح والطالح معا... كالرياح الهوج تطيح بالأخضر واليابس معا، وبالشجرة المثمرة والشجرة الصفراء جميعا. أما (( الثورة )) فهي تبقي النافع وتستمد منه القوة.. بل وتصدر عنه أحيانا، وتقضي فقط على البالي المتهافت، المعوق للحيوية، المغلق لنوافذ الهواء المتجدد، الواقف في طريق التجديد والتطور. ولكن المسألة ليست دائما بهذه البساطة. فالثورة والهوجة تختلطان أحيانا، إن لم يكن في كل الأحيان. فالثورة كي تؤكد ذاتها وتثبت أقدامها تلجأ إلى عنف الهوجة كل ما كان قبلها... وتجعل بداية كل خير هو بدايتها، وتاريخ كل شئ هو تاريخها... ولا يتغير هذا الحال إلا عندما تشعر الثورة بصلابة عودها وتوقن أنه قد أصبح لها وجه واضح وشخصية متميزة ومكان راسخ في التاريخ العام... عندئذ تنبذ عنها عنصر الهوجة وتأنف منه، وتعود بكل اطمئنان إلى تاريخ الأمة العام لتضع كل قيمة في مكانها الصحيح، وتضع نفسها في الحجم المعقول، داخل إطار التسلسل الطبيعي لتطور أمة ناهضة.. إذا عرفنا ذلك، كان من الميسور أن نفهم حركات الأجيال الجديدة، أو ما يسمى.. بـ" ثورة الشباب "
جدلية الفلسفة السياسية والمنهج عند هيجل
4.000 KD
وجدنا أن مشكلة البحث: تنطلق من عنوان الموضوع الذي يشكل بعنوانه، ثرية للنص، موجهاً وهادياً، ويمكننا أن نحدد أبعاد هذا المشكلة التي تمثلت في عنوان الموضوع، حيث تقوم على غياب التواصل بين الفلسفة والتاريخ، هذا الغياب الذي تسبب في حدوث الهوة الكبيرة بين المؤرخ والفيلسوف، ونتج عنه إختلاف الرؤية للتاريخ بينهما، وإن غياب العلاقة بين الفلسفة والتاريخ له أسباب كثيرة.
يبدو لأن أن دراسة العلاقة بين الفلسفة بوصفها الحاضنة، والمنهج التاريخي بوصفه ملازماً، قد تعرضت إلى التغييب من قبل كثير من الباحثين الذي يرون أن المنهج التاريخي، منعزل ومستقل تماماً عن الفلسفة، وذلك أن المنهج التاريخي لديهم حاز على الإستقلالية والخصوصية، مما أعطاهم حق التصريح بإمكانية دراسة التاريخ من دون الرجوع إلى الفلسفة ويقابل هذه الأفكار آخرون يحاولون تجاهل إستقلالية علم التاريخ وجعله تابع للفلسفة، محاولين طمس هوية التاريخ، متجاهلين ما للتاريخ من أثر في رسم مسارات الامم.
فبين هذين الفريقين ظهرت هذه المشكلة، مشكلة التواصل بين التاريخ والفلسفة، ومردها أن فلسفة التاريخ، غالباً ما يتم تدريسها من قبل أساتذة في التاريخ، ليس لديهم درجة علمية تؤهلهم تخصصياً، أو ممن لديهم دراية تخصصية في الفلسفة، لكن ليس لديهم اهتمام بالتاريخ ومناهج البحث التاريخي، مما يجعله يصدر أحكاماً قبلية على التاريخ ومنهجه، وهذه الأحكام عادة ما تكون لدى أساتذة الفلسفة الذين ليس لديهم درجة تخصصية في المنهج التاريخي
عدد الصفحات : ٢٤٨
جلال الدين الرومي : بين الصوفية وعلماء الكلام
4.000 KD
الكتاب دراسة لأحد أشهر علماء الصوفية وهو جلال الدين الرومي ، والكتاب لا يكتفي بالحديث عن جلال الدين الرومي فقط ، بل يتناول في بدايته تاريخ الصوفية وتطورها حتى عصر جلال الدين الرومي ، ثم يبدأ في تناول سيرة جلال الدين وحياته ونشأته ، ثم مؤلفاته وآثاره ، ثم يفرد فصلاً حول علاقته بالصوفية وآرائه الصوفية ، وخصص أخر فصول الكتاب حول تأثر جلال الدين الرومي بعلم الكلام وأهم آرائه الفلسفية التي دعت البعض إلى تصنيفه ضمن علماء الكلام ، وليس من علماء التصوف الإسلامي.